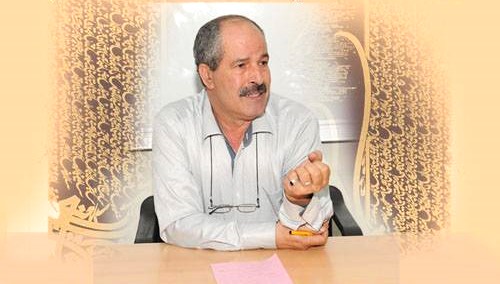
أثارت الحرب على غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) طوفانا من الأخبار يعكس حجم الأحداث التي تولدت عنه، والتي ظل فيها الجيش الإسرائيلي مدعوما بالمرتزقة والدعم الأمريكي والغربي اللامحدود يمارس التدمير والتقتيل بلا توقف. فليس هناك تمييز بين الليل أو النهار. فالغارات والأسلحة الرقمية والذخائر الأمريكية التي تتعزز بها هذه الحرب، متواصلة على أشدها لتحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة. وحتى في لحظات الهدنة كان التوجه إلى الضفة بالطريقة نفسها، وكأن العدوان وصل أقصى درجات الجنون فصارت حركاته لا نهائية.
في ظل هذا الطغيان والجبروت لا يمكن للأخبار إلا أن تتناسل عن طريق استغلال مختلف الوسائط القديمة والجديدة. وكان الإعلام الغربي منحازا منذ البداية لافتراءات الراوي الصهيوني، وهو يقدم صورة وحشية عن حماس التي ذبحت الأطفال والمدنيين، وتم تقديمهم بالصورة المستنسخة عن القاعدة والدواعش. كان الانجراف إلى الصورة الخبرية الصهيونية التي روجت لها أمريكا بقدر يفوق ما يتخيل المرء، وصار الغرب في الاتجاه نفسه قبل بداية التحول البسيط الذي أبان للعالم أجمع كذب الادعاءات الصهيونية والأمريكية، وبدأ أحرار العالم يرون الحقيقة ناصعة، ولا سيما بعد ما بدا للجميع حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة بلادا وعبادا. وبعد وصول هذه الحرب إلى عتبة الشهر الثالث من التدمير الذي يقر المتتبعون أنه لا نظير له في تاريخ الحروب الحديثة، وإلى التهجير الذي يمارس ضد سكان غزة واستهدافهم، ظل الاحتلال الصهيوني يواصل عمله الوحشي غير معتبر النداءات العالمية لوقف إطلاق النار. بل إن كل من يستنكر الدمار الشامل يعد نصيرا للإرهاب.
بدت الصهيونية من خلال هذه الحرب، وما ولدته من أخبار يهيمن فيها الإعلام الغربي والأمريكي أن الصهيونية مقدسة، وكل من يمسها تحق عليه اللعنة، وحتى الأمين العام للأمم المتحدة صار متهما في مواقفه، وهو يطالب بوقف النار. بل إن الفنانين الذين عبروا عن آرائهم عن التطهير العرقي الصهيوني اتهموا بدعمهم لحماس، ومساندتهم للإرهابيين، ودعوتهم إلى الكراهية. وعندما سخرت ناشطة التواصل الاجتماعي بما روجت له الدعاية الصهيونية عن الأطفال الذين علقتهم حماس على حبل الغسيل، أو أدخلتهم إلى الأفران، بإشارتها إلى إضافة الملح والفلفل حكمت عليها فرنسا بالسجن، وأداء غرامة مالية. والأمثلة لا حصر لها لمن يريد أن يتابع ما جرى في هذه الحرب التي لا نجد أي كلمة، وبأي لغة، تستطيع وصفها.
فماذا حقق نتنياهو من هذه الحرب التي يعبر من خلالها عن جنونه، كما وصفه مرة الملك الراحل الحسن الثاني. إنه فعلا مجنون، ومهووس بسفك الدماء، وهو إلى جانب ذلك فاسد ومتابع قضائيا. إن هربه إلى الأمام بعدم سماعه لمواطنيه، لا يمارس التقتيل فقط ضد الفلسطينيين، ولكن أيضا ضد المواطنين الإسرائيليين الذين بدأوا يعرفونه جيدا. إن غسل دماغ الإسرائيلي بدأ يفقد دوره بجلاء ولا سيما مع قضايا الرهائن. ولكنه ليس استثناء في هذا فالتربية على الأسطورة الصهيونية ولدت أجيالا لها علاقة وطيدة بالآباء المجرمين. لقد رأينا الجنود الصهاينة كيف يمارسون جنونهم، وهم يتلذذون بقنص المعوقين، والأطفال، وكيفية ممارستهم اعتقال المواطنين من الضفة، وكيف يعرون المدنيين، ويصطفونهم، ويقدمونهم للمواطن الإسرائيلي على أنها إنجازات حربية عظيمة.
ورغم كل ما صار واضحا مع تطور الوسائل الجديدة للتواصل نجدهم يدعون زورا وبهتانا، ما تقوم به حماس. لقد لاحظ العالم كيف كانت تودع الرهائن مرافقيها من المقاومين، وعملوا على إسكاتهم لقول الطريقة الإنسانية التي عوملوا بها بالقياس إلى ما يتبجح به الصهاينة من تكسير لأيادي وأرجل الأطفال المعتقلين والمسرحين. كما ساءهم ما عبر عنه من شملهم التسريح من الفلسطينيين من معاناة التنكيل والاعتقال، وما كانوا يمارسونه ضدهم من ألوان التعذيب والإهانة. لم يرضهم كل ذلك لما ظهرت الصورة الخبرية للمقاومة الفلسطينية، وهي ذات دلالات إنسانية، فما كان منهم سوى العمل على تشويه تلك الصورة التي بدأت تغير الرأي العام داخل إسرائيل، وفي العالم أجمع، فكان أن تم تسويق عدم مواصلة حماس إطلاق الرهائن بسبب كونهم أساؤوا معاملة الإسرائيليات اللواتي تعرضن للاغتصاب، والتمثيل بأعضائهن الجنسية، وما شابه هذا من الافتراءات التي تكذبها الأسيرات المسرحات اللواتي تحدثن قبل أن تعمل الصهيونية على إسكاتهن. ومع سماع ما قلنه من معاملة حسنة، ورؤية كيفية مغادرتهن وتوديعهن للمقاومة كان ادعاء أنهن كن مخدرات؟
لو أن تشويه صورة المقاومة في تعاملها مع الأسيرات جاء على لسان الإعلام الصهيوني لكان عاديا في نطاق الحرب النفسية. ولكن أن يأتي ذلك على لسان رئيس أمريكا فليس سوى تأكيد أن أمريكا ضالعة في المؤامرة والحرب القذرة، وأنها تريد أن تقوم الآلة العسكرية الصهيونية بإنجاز مهمتها في الإبادة العرقية، وأن كل ما يقال عن دعوتها إلى عدم المساس بالمدنيين فخطاب مسموم، ولا قيمة له. كما أن المطالبة بإنهاء الحرب في مطلع سنة 2024 إلا دعوة صريحة بسعي إسرائيل إلى تسريع إنجاز مهمتها التاريخية في إقبار القضية الفلسطينية.
مر أكثر من شهرين على هذه الحرب القذرة، وهي أطول الحروب التي كشفت عورة إسرائيل ماديا ومعنويا، فماذا تحقق من أهدافها المعلنة الثلاثة؟ لم يتحقق أي منها، ولن يتحقق أبدا. بل ظهرت القضية الفلسطينية في أوج زخمها رغم كل أشكال المعاناة والمآسي والآلام. لقد أبانت المقاومة على أنها صاحبة قضية لا تنتهي بالتقادم، ولا بالتواطؤ، وأنها حبلى بلا ما يتوقع وبما لا ينتظر. لكن تلك الأهداف المتصلة بتحرير الرهائن، والقضاء على حماس ورموزها الوطنية، وتحييد حماس، ليست سوى عناوين كبرى في جريدة من جرائد الرصيف. إن تلك العناوين تخفي وراءها الهدف الإسرائيلي الأكبر، والذي يمثل أسطورتها الشخصية، وهي إنهاء القضية الفلسطينية، وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى. وما تقتيل الفلسطينيين بالآلاف وتدمير مساكنهم، وتهجير من بقي منهم بعد المجازر الوحشية التي يعملون على إيصالها إلى أكثر من عشرين ألف شهيد، علاوة على المعوقين، والجرحى، والمعطوبين نفسيا، وتدمير ما بقي من الآثار الدالة على وجود ووجدان. فما هي آثار هذه الحرب القذرة داخل إسرائيل؟ إنهم لا يتحدثون عنها إلا وهم ساخطون، ومنهزمون. وما بداية الهجرة إلى خارج إسرائيل دون التفكير في الرجوع إليها إلا تعبير عن بداية انهيار تلك الأسطورة.
هذه الحرب التي شنها محتل غاشم على شعب يسعى إلى تحقيق حرية وطنه واسترجاع حقوقه المغصوبة إدانة للبشرية جمعاء التي لم تنظر في معاناة شعب كامل مستهدف بأعتى الأسلحة وبتواطؤ واضح من دول العالم أجمع الذي ظل يصدق أخبارا كاذبة، ويروج لأحاديث باطلة. حين يقتّل الأطفال والشيوخ والنساء بالآلاف ويُجوَّعون، وتُدمّر البنيات التحتية للقطاع، ويعتقل الآلاف، فلا يمكننا الحديث إلا على استحياء عن “الضمير العالمي” وعن “الإنسانية” وعن “التنوير” وعن “الحداثة” وعن كل القيم التي يدعي الغرب أنه جاء بها لإسعاد البشرية، وإخراجها من الظلمات إلى النور. لو قارنا عدد ضحايا البشرية قبل هيمنة الحضارة الغربية بما تحقق خلالها لوجدناها حضارة ذات مدلول دموي، وإن كان الدال الذي توظفه ناعما. فمتى يستيقظ المنهزمون والمتوهمون ليروا أخبارا زائفة تقدم باعتبارها حقيقة.








