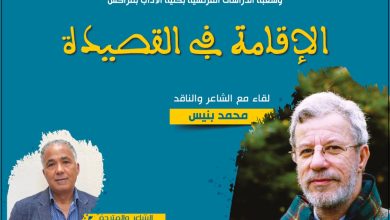منذ زمن غير بعيد ،لم يعد أمر اعتبار سنة تنقضي، شيئا يمكن أن أقف عنده منبهرة، في انتظار سنة أخرى قادمة، كما لاتجدني ألحق بكلتيهما صفة القدم والجدة ،بل حتى انني لا أجد مبررا ل”توديع” “القديمة “، و”استقبال”تلك التي تعتبر ” جديدة “.
لم يعد الأمر يستلزم كل هذا العناء، منذ أن أدركت أن الأمر يتعلق باستمرارية بين زمانين متلاحقين، تدوم مدة الواحد منهما 365 يوما.
وجدتها فقط تقف عند حدود الرقم الذي تحمله، ذلك أن الحديث عن سنة جديدة، يفترض أننا سنكون فعليا أمام ما لم يسبق له أن كان ، فذاك هو المقصود بالجديد، والحال أن تجربتنا السابقة التي عشناها طوال سنوات خلت، كشفت عن غياب هذا الذي لم يسبق له أن كان أي غياب الجديد لأننا نكون فقط أمام ماهو كائن، مع بعض التعديل .
الجميع يمني النفس بقادم أجمل ، ويدعو للأغيار بذلك يأمل ، ويحلم بأننا جميعا مقبلين على “جديد”، أي على الذي سيأتي، إلا أنه لا يأتي .
عودتنا السنوات الخوالي التي تعاقبت، فكان “جديدها “يحل محل “قديمها”، وهكذا تتناسل السنوات، ومعها الآمال والأحلام، والوعود بمصير أفضل للإنسان .
لكن، ما نصحو عليه دائما، لم يكن سوى كونا مثقلا بالآلام والحسرات. كون أعيت ساكنته الحروب والمجاعات والأوبئة الفتاكة، الصراعات المدمرة الخفية والمعلنة، والتي تحركها المصالح والاطماع، إلى حد الهوس الزائد عن حده ، والمنقلب غالبا إلى ممارسات لا مفهومة ولا مستساغة، لأنها نتاج الهوى واستخدام العقل بشكل فاسد ، لتكون حصيلتها :
أزمات اقتصادية ، تزيد من درجات البؤس في العالم ،ازمات سياسة تعرقل السلام فيه. تصادم حتى بين من كانوايعتبرون أشقاء ليتحولوا الى أعداء خصوصا حين يتحولون إلى أدوات في يد قوى عالمية كبرى .
أيضا ثمة ما يقلق ، ونحن نشهد احتدام الصراع بين دول الشمال والجنوب، الذي في كل مرة يأخد طابعا ، وأبعادا حسب كل مرحلة من مراحل التاريخ . لنكون أمام غياب توازن في العلاقات بين هذه الدول، وبالتالي غياب عدالة كونية ، مادام هناك إصرار على استنزاف خيرات دول الجنوب التي لا تستطيع ان تفك الحصار المضروب عليها من طرف هذا الاخطبوط الذي لا يترك أمامها أية فرصة للتحرر الحقيقي. والتي ما تفتأ تقاوم هيمنته وغطرسته متى تأتى لها ذلك .(الأحداث التي عاشها المغرب مؤخرا ).
وكم يسوء الأمر، ونحن نشهد اندحار قوى اليسار عبر العالم، في الوقت الذي يعرف اليمين انتعاشا قويا يهدد ما بقي من فرص السلام فيه ،
يمين أحيانا يصاب بهذيان مريض (زيموري الطبيعة )، أو غيره ،في تغييب تام منه لتحليل عقلاني، شفاف وشجاع، لما يجري على أرض الواقع. ليرمي بدون تحسب لخطورة ما سوف تسفر عنه الأحداث ،بما يعتبره حلولا ، وهي في حقيقة أمرها ،لن تزيد إلا من تعميق الازمات الكائنة .
كما انه ليس عليناان ننسى الزحف الظلامي على حساب قوى التنوير ،وما يحدثه ذلك من قتامة في المشهد السياسي والفكري وانعكاسهما على وجود الافراد داخل مجتمعات تئن تحت وطأة ،الفقر والجهل والأمية ،وانتشار قيم تئد كل حق في الحياة الكريمة ، فيكون نصيب النساء من هذا الوضع المتردي مضاعفا، وتجهض كل الاحلام في إمكانية تحقق وثبة نحو وضعية أحسن .
غياب المساواة بين الجنسين، بين الطبقات ،بين الشعوب ،بين الثقافات …هو ما يسم عالمنا اليوم .
أيضا، غياب الحريات المنعشة للذوات الإنسانية، المحافظة على الجوهر الانساني ،وكذا الضمانات بأن هناك عدالة سوف تكون من نصيب كل من يحيا على هذه الأرض .
كل هذا يصبح في عداد أوهام كثيرة، تصاحبنا كما ٱمالنا ونحن “نودع “سنة ، و”نستقبل “أخرى، لتتمدد الاماني ،و تتعاظم في نفس كل من لا زال يؤمن، أن سنة على أبواب الوصول تحمل معها “الجديد “المنتظر .
لكن ، وحتى لا نكون ممن أذهب اليأس بصيرتهم، يمكن أن ننفتح جميعنا نحن الأفراد البشريين ، الذين يراهنون على تحقق العدالة وإلانصاف، كما دعا الى ذلك الفيلسوف جون راولز ، من خلال عقد اجتماعي مغاير، في ظل مجتمع ديمقراطي حداثي بامتياز. ضامن للحرية والمساواة للجميع ، تحت سقف القانون من أجل مصلحة المجتمع .