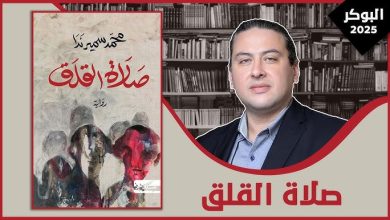تفاعل كثير من المهتمين بالرسالة الملكية إلى المحتفين بذكرى تشييد ومأسسة العمل الإستشاري/ البرلماني ؛ فمن اعتبرها تنبيه إلى الهشاشة التي بلغتها هذه المؤسسة بمجلسيها بسبب سلوكات المنتخبين نوابا ومستشارين ؛ ومن صنف الرسالة بمثابة نقد ذاتي للدولة بجميع مكوناتها وتعبيراتها ؛ وإن كنا لا نرى غاية مفيدة من التمييز بين المؤسسات والمنتخبين ؛ باعتبار أن السلوكات المؤسستية معرضة للأخطاء وبنفس القدر يفترض أن المسؤولية تثار في جميع الحالات ؛ ففيها ما هو مرفقي أي مصلحي تتحمله الدولة وفيها ما هو شخصي يساءل بصدده المنتخبون سياسيا وقانونيا.
ولأن الأمر لم يكن إلى كثير تشخيص وافتحاص ؛ فما يؤرق الدولة المغربية في شخص رئيسها هو تفاقم الوضع نحو ما لا يمكن إحتواؤه ، وقد عشنا منذ سنوات الرصاص حالات اضطرت فيها العقل الأمني إلى ضرورة إجراء حملات تطهيرية ، حملة طارئة تستهدف التشذيب دون الإستئصال في صيغة حرب قانونية أهلية تخص موظفي الدولة في كل السلاليم ، عموديا وافقيا بموازاة مع بعض الإصلاحات السياسية الرمزية غير العميقة .
وقد فطن النجباء إلى أن هناك تحضيرا لإنتقال ما ؛ وفعلا تحققت التوقعات بجسير الإنتقال السياسي من عهد إلى عهد عبر بوابة التناوب التوافقي ؛ فهل سيتكرر السيناريو بتدشين إنفراج جديد بتخليق الحياة العامة وتصفية البيئة الحقوقية والأجواء السياسية ؛ وإذا كانت الرسالة الملكية قد ركزت على أهمية بلورة مدونة الأخلاقيات البرامانية ؛ قياسا على على مدونة الأخلاقيات القضائية ؛ فإن السؤال ينبغي أن يطرح ليس فقط على جدية العملية التخليقية ( تمييزا لها عن الحملة التطهيرية والتي كان لها ضحايا كثر وأكباش فداء عديدون ، ولكن وجب التركيز أساسا على جدواها ” الدستوري ” ! فالمطلوب توفير إرادة حقيقية لإفتحاص الوضع إفتحاصا دستوريا وليس فقط بعث رسائل تحذير في كل الجهات من أجل إستخلاص حلول للازمة العامة التي تعرفها الحياة السياسية في العلاقة مع إشتغال المؤسسات العمومية والدستورية ؛ وفي نظرنا لا يكفي البحث في النتائج بل من معالجة الأسباب الجذرية العميقة ؛ فالازمة بنيوية متوارثة منذ تبني الدولة المغرب لخيار الدبمقراطية التمثلية في ظل مجال سياسي مغلق يخشى اليقين ولا يطلق العنان للمشاركة السياسية الحقيقية ؛ ولذلك وجب التمحيص والتشخيص في الهندسة الدستورية للنظام السياسي المغربي الذي وإن وسع مجال التشريع لفائدة مؤسسة البرلمان بمجلسيه ؛ فإن السلطة التنفيذية برأسيها لا تطوقها فوبيا الإنفلات ، لذلك ظلت تمسك على جمر ” المبادرة التشريعية بتكريس إحتكارها عن طريق ما يسمى بآلية ” العقلنة البرلمانية ” والتي تهدف الحد من نفوذ القدرة التشريعية والرقابية لدى البرلمان بعلة ” ترشيد المحاسبة وصناعة القانون ” رغم أن الخلفية الحقيقية هي ضمان الإستقرار الحكومي ؛ بعيدا عن جدية المساءلة البرلمانية للحكومة ومساءلتها سياسيا .
إنه فعلا إحتكاك سياسي بين سلطتين إحداها صاحبة الإختصاص الحكر في مجال القانون والثانية تستعمل آلية العقلنة البرلمانية للحد من المبادرة التشريعية ؛ ولذلك وجب تعديل المطلب / العرض السياسي للدولة ؛ فهل هي في حاجة إلى تخليق موظفي مؤسسة تابعة لها ؛ لتماهي الصلاحيات والمسؤولية في ظل فصل ” دستوري ” للسلط ولكن بتعاون بعضها مع بعض عوض إستقلال بعضها عن بعض ؛ تحت إشراف مؤسسة دستورية تعتبر جميع المجالات السياسية محفوظة لديها ؛ وسنعود للتفصيل لاحقا في هذه الظاهرة البنيوية لنظام يشتغل بمنطق التكيف بدل التحول ؛ ولكن قبل ختم هذه المقالة لابد من التأكيد على أن المطلوب ليس فقط تخليق الحياة البرلمانية ولكن ضرورة طرح جدوى الديمقراطية التمثيلية وهي الهاضعة لحتمية الخريطة الإنتخابية المؤطرة بهاجس التقطيع السياسي ، ولذلك فإن العقدة تكمن في عقيدة العقلنة البرلمانية والتي تؤطر كل عمليات إحتكار صناعة القرار الأمني والتشريعي ، والذي يجسده مظهر تحكم السلطة التنفيذية ( الحكومة وزارة المالية ) في صناعة القرار المالي عبر قانون المالية ، لأن كل قرار مالي هو أمني قبل أن يكون سياسي.
فلنتذكر أن العملية الإنتخابية في كليتها رغم تسميتها بالتشريعية فما هي إلا وسيلة لتوفير المناخ / الفرصة لإختيار رئيس الحكومة والذي سيتولى إقتراح الوزراء / أعضاء الحكومة ، وليتجلى في آخر التحليل بأن الدولة تبادر بين الفينة والأخرى إلى تقويم سياسيتها وتأديب موظفيها ومحاسبة المساهمين فيها ؛ فليست الدولة جهازا فقط بل الطبقة السياسية نفسها تهيمن إقتصاديا وتسيطر سياسيا ، وفي ذلك صعوبة للحديث عن فصل حقيقي للسلط والمجالات بما فيها فصل المال عن السياسة ؛ وهو مطلب تم تهريبه بحذفه من مسودة دستور 2011 ، بتواطئ من دعاة الشرعية الدينية حتى لا نقول السلطة الدينية .
ـ رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي .