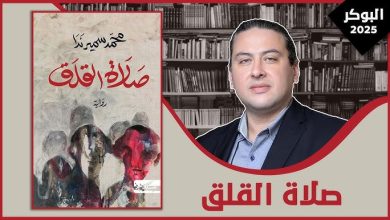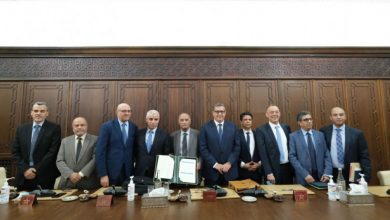بمناسبة اليوم العالمي للكِتاب، يسعدني أن أتقدّم بالتّحية الصّادقة لروح الدكتور محمد عطية الإبراشي، الذي زرع في قلبي محبّة الكُتب السّاحرة منذ الطّفولة، وإلى كلّ من ساهم بعده سواء بفكره أو خياله الثّري في تكوين شخصيتي، من الكُتّاب والكاتبات (الأحياء منهم والأموات!)؛ والى جميع الذين ما زالوا يؤمنون الى حدّ الآن، بأهمية هذا الوسيط الحداثي الرائع في حياتنا اليوميّة، سواء أحمل فكرا، أم أدبا، أم أنه ينتمي الى دائرة العلوم، بمختلف شِعابها وفروعها؛ وأخصّ بالذّكر الأصدقاء الكُتّاب والكاتبات، وأصحاب/صاحبات دور النّشر والمكتبات، والقائمين كما القائمات عليها، والقرّاء والقارئات أيضا، في كافّة أنحاء الوطن العربي،،، وكلّ عام والكِتاب بألف خير!
وبهذه المناسبة، أتقاسم معكم، نصّا “في مديح الكتاب” كنت قد ترجمته منذ أكثر من عشر سنوات، للرّوائي الفرنسيّ الرّاحل جون دورميسون Jean d’Ormesson، ولم يسبق لي قطّ أن نشرته.
“في الوقت الذي بقيت دار الأوبرا مسكونة بذكرى الحناجر الصّادحة، وسحر الرّقَصات الآسرة التي خلّدها دوگا، احتفلنا يوم الأحد الماضي جميعا، كقراء وكُتّاب – ولا قيمة لوجود البعض منّا، دون وجود البعض الآخر! – بشيء شبْهِ مُقدس، ساهم على امتداد قرون خوال، في تغيير ملامح العالم: وأعني به الكتاب. إنّ الكتاب لم يوجد أبدا بيننا، وإنّما مرّت ملايين السّنين دونه. ومَن يُدرينا بأنّه سيظلّ بيننا، بعد مرور آلاف السّنوات الأخرى؟إنّما يبقى لنا على كلّ حال، أن نعترف بأنّه تحكّم – ولمئات السّنين – في مصيرنا، وامتدّ تحكّمه على مدى فترات امتدّتْ ما بين مرحلة اكتشاف النّار، واعتماد نظام الزّراعة، وإنشاء المدن، واختراع الرّجُل الآلي والمعلوميّات.
لقدْ ألْفَتْ وقائعُ الحروبِ في الكتاب، مثلما وجدتْ فيه أحوالُ السّلم ونوازل الموت وموضوعات المعرفة والجمال والجنون والّلذة والحبّ وتقديس المطلق، حيّزاً لا يستهان به لتسجيل حضورها على صفحاته. ومن ثمّ، أمسى الكتابُ وكافّة الدّعائم الورقيّة المشتقّة عنه، بمثابة التّاريخ ذاته؛ بما في ذلك الخريطة والصّحيفة والسّجِل وكلّ الدّعائم الأخرى، التي ارتسمتْ عليها العلاماتُ التي تحمل معنى.
لقد تداخلتْ جميع تلك الدّعائم بالتّاريخ، واندغمت بلحظاته، الى أن صار من المستحيل الفصلُ بينها وبينه. ولا غرو في هذا، إذا عرفنا بأنّ تلك الدّعامات هي التي شَيّدتْ صرحَ التّاريخ، ورفعتْ بناءه، أكثر مما فعله أيُّ إنسان آخر، أو أيّ شيء آخر. وإذا كان هذا هو حال الكتاب بالأمس، فإنّه ما انفكّ اليوم – في هذا العالم الذي فتق الإنسانُ أسراره، وغيّر من ملامحه – يجعلنا نحلم، ويمنحنا القوّة والمَنَعة.فنحن نقرأ كي نتعلّم، وكي نُكوّنَ أنفسنا، ونَفْهمَ. غير أنّنا نقرأ أيضاً، كي نحلم.
إنّ ثمّة عالماً آخر مُضاعِفا لعالمنا الأول، ما يلبث أنْ يتولّد عن الأدب، وخاصّة عن الرّواية التي أخذتْ تحتلّ منذ القرن الماضي، حيزاً استثنائيّاً وغير عاديّ، على الأقلّ من حيث الكمّ. ففي منظومة أساطيرنا الجَماعيّة والخاصّة، اكتسبتْ شخصيّة أوليس Ulysse، مثلما اكتسب گارْگانْتييا Gargantua، ودون كيشوت Don Quichotte، وگافْروش Gavroche، وجوليان سوريل Julien Sorel، وراستينْياك Rastignac، وسُوان Swann، وأوديت Odette ، نفسَ القدر من الحقيقة الذي اكتسبه القيْصر César، ونالتْه كيلوباترا Cléopâtre، وألكسندر المقدوني Alexandre، والملك شارلومان Charlemagne.
إنّ الرّب – ذلك الرّوائي الكبير، صاحب قصة الخَلْق – قد أناب عنه اليوم الرّوائيين، فصار هؤلاء ينافسونه في قصّة خلقه الأولى، ويتصوّرون أنفسهم آلهة. فصرنا من ثمّة نعيش بين وقائع الكتب، بنفس القدر الذي نعيشه في عالم الواقع الحقّ.
وما زال بمستطاع الكتاب أن يمنحنا، بنفس القدر الذي تستطيع أن تمنحنا إياه الموسيقى والفنون التّشكيلية والرّقص، فكرة السّمو والرّفعة والجمال، في عالم غدا اليوم مهدّداً، وصارت معالمه مُهْوشّة ومُشَوهة في الأغلب الأعم، بفعل السّيارات والإسمنت والتّقدم التّكنولوجي.
إنّ ثمّة كتبا رديئة، مثلما ثمّة من الكتب ما من شأنه أنْ يرتقي بنا الى السّماوات العُلى، بعيداً عن ذواتنا، حتّى إنّا لا نقوى على فِراقها أبدا: فلكم نتمنّى ألاّ ينتهي ذلك الكتاب بالمرّة، وإنّما أن يستمرّ في حملنا معه بعيداً، ولفترات طويلة!ففي رُبوع مَدنيّة فَسُد طبْعُها بموسيقى خرقاء، تُجْتزاُ اجتزاءَ النّقانق على مدار النّهار كلّه، وفَتُرتْ هِمّتها بفعل تلفزيون مُروّع ومُرهِق في أغلب الأوقات، يبقى فعلُ القراءة والكتابة من بين الأنشطة الأقدر على الارتقاء بالإنسانيّة، فوق الابتذال اليوميّ.
ولعلّ كلّ واحد منّا يتذكّر من غير شكّ، إمّا صبيحةً من أصباح الصّيف، أو أمسية من أماسي الشّتاء، حين تستبدّ بالمرء سعادةُ القراءة، فتحلّق به عالياً بين أرجاء عوالم مجهولة، وهو إمّا برفقة أرسين لوبينArsène Lupin ، أو فابريس ديل دونغوFabrice del Dongo ، أو صديقتي نانMon ami Nane ، أو سكارليت أوهاراScarlett O’Hara ، أو كانديدCandide ، أو فيدر Phèdre .وسواء كانت الغاية منه هي الاستمتاع أو التّهذيب والتّربية، أو كانت هي التّرويح عن النّفس، أو الاغتراف من معين المعرفة والتّأمل، فإنّ الكتاب شيءٌ فريدٌ من نوعه، لا محيذ عنه.
ويُشاع اليوم بأنّ الصورةَ والحاسوبَ صارا يهددان وجود الكتاب، إلاّ أنّي آمل، وأصدّق آمالي، مع كلّ ما يحظى به عهدُ التّقنية الجديدة من أهمية، بأن يظلّ الكتاب في منأى عن لحظة نهايته، ذلك أنّه – وبامتياز – من أكثر الأشياء التي تسمح بالاستثارة الخصيبة للذّكرى والحلم والخيال، أكثر مما تسمح به بداهة الآلة والصّورة كذلك، اللّتان لا تستطيعان بفعل قوتهما المفرطة بالذّات، أن تضاهيا استثاراته الخصيبة. فالكتاب يتيح لنا من حرّية التصرّف، أكثر ممّا يتيحه لنا أيّ شيء آخر. فنحن نختاره، فنتركه للحظة مهملاً، ثمّ نعود إليه، لنعثر فيه مجدّدا على جملة منسيّة، ظلت تطِنّ لوقت مديد بين حنايا روحنا. وإذا كانت المعلوميّات توفر لنا الأجوبة، فإنّ ما سيدفع بالمرء في اتّجاه البحث بين بطون الكتب، هو بعض الأسئلة تحديداً. إنّ الصّورة التي تظهر على الشّاشة، تفرض نفسها فرضاً على المشاهد، بينما يترك الحكيُ في الكتاب، المجالَ متّسعا جدّا وحرّاً للغاية أمام خيال القارئ.
إنّ الكتاب يتطلّب من قرّائه، على النّقيض من الآلة والتّلفزيون، مشاركة فعّالة تنبع من أرواحهم، وتَعِد بذلك وعداً صادقا لإدراك السّعادة، والتّحرر الدّاخلي. وما دامت ستبقى ثمّة كتب، ومَن يؤلفها ويقرأها، فإنّ ما من شيء سنخسره في هذا العالم، الذي شدّ ما أحببناه وتعلّقنا به، رغم أحزانه وفظاعاته!فعيداً سعيداً! ومزيداً من الكتب الجيّدة!