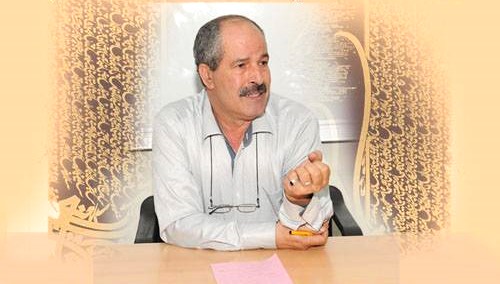
درج معلمونا وأساتذتنا على طرح السؤال الذي لا يحتمل إلا الجواب الواحد. ولم يكن بمقدور تلامذتنا أو طلبتنا أن يفكروا إلا في الجواب الذي لا يمكن أن يكون إلا مشتركا. لذلك ساد التلقين، وهيمن الحفظ، ورد البضاعة إلى أصحابها؟ وحتى الذين يملؤون الآن الحلاقي الافتراضية بأحاديثهم الفجة والسخيفة، لا يختلفون عن نظرائهم الذين نهلوا معهم من التكوين نفسه، إلا أنهم، وإن حاولوا الإبانة عن اختلاف في التفكير، وفي طرح السؤال حول التاريخ وتجديد الخطاب الديني، يعودون إلى بضاعات من سبقهم من أصحاب الملل والنحل قديما، وما خلفه المستشرقون المتعصبون حديثا بلا تفكير ولا منهج، ويقدمونها لنا على أنها من خالص فكرهم السليم، ومن اجتهاداتهم التي ينفردون بها عمن يتهمونهم بالجهل والتخلف.
طرح السؤال أشكال وألوان.. إنه فطرة إنسانية تبدأ من دهشة الطفل من رؤية الأشياء فيبدأ في التساؤل عنها، ومحاولة معرفة أصولها، وفهم طبيعتها، لكن الفطرة السليمة حين تدمرها التربية العقيمة يغيب عنها طرح السؤال، فلا تقبل إلا الجاهز من التصورات والآراء دون تمهل أو إعمال للنظر، وبذلك تسود الأفكار والعادات والتقاليد التي يمكن أن تهيمن لعدة قرون، ولا تتغير إلا بعد حدوث الرجّات الكبرى التي تدفعها إلى إعادة النظر في ما ظلت تعتقده مدة طويلة من الزمن.
جاء الإسلام رجة كبرى في تاريخ البشرية، بطرح السؤال حول الكون، والإنسان ومصير كل منهما. فعارضه من ظلوا يرون أن ما وجدوا عليه آباءهم هو الطريق القويم، ولا يمكنهم الانصراف عنه. كان القرآن الكريم خطابا جديدا يدعو إلى التفكر في الخلق، وفي الدعوة إلى العلم، وظل يفرق بين من يعلم ومن لا يعلم. ويزخر بالآيات التي تدعو إلى طرح السؤال وإعمال النظر في ما يحيط بالإنسان لإدراك حقيقة واقعه ومعاشه عبر التأمل في الواقع الذي يحيط به. إن مادة (س.أ.ل) بمختلف الصيغ التي وردت بها تتكرر في القرآن الكريم 130 مرة. وفي خطاب إلى الرسول دعوة صريحة إلى السؤال: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرِؤون الكتاب من قبلك» (يونس 94). وفي الحديث النبوي نجد السؤال يحظى بمكانة خاصة، ولو وقفنا فقط على نوع من أنواعه وهو: السؤالات والأجوبة، لوجدنا ذلك يتصل بمختلف جوانب الحياة الدينية والدنيوية. وفي هذا تأكيد للصلة الوثيقة بين الحديث النبوي والخطاب القرآني.
تبدو لنا بجلاء أهمية السؤال في الثقافة العربية الإسلامية، من خلال بروز العلوم المختلفة، وما تركه لنا العلماء المسلمون من أدبيات غزيرة تتعلق بآداب التعلم والسماع والحرص على طلب العلم لا ننتبه إليها حاليا، ولا نوجه طلبتنا إليها لهيمنة التقليد، ما يؤكد لنا ذلك بجلاء، ويمكننا الذهاب إلى أن مساهمة المسلمين في الحضارة الإنسانية ما كانت لتكون لولا ما دعا إليه القرآن الكريم والحديث النبوي، وما حثا عليه بخصوص العلم، وممارسة المسلمين لذلك بهمة وحرص وتفان. ويبدو لنا من خلال ما خلفوه من مؤلفات ذات طبيعة «إبستيمولوجية» واضحة. ولما انتهى طرح السؤال كان الانحطاط والتخلف عن ركب الحضارة.
كانت الرجة الثانية مع عصر الأنوار وبعد ذلك مع الثورة التكنولوجية، حيث برزت العلوم، وكانت قولة باشلار المشهورة: «أول العلم السؤال» عنوان تصور جديد لرؤية العالم والدعوة إلى البحث فيه من منظور علمي. ولذلك سادت الحضارة الغربية الحديثة، التي لم نستفد منها لعدم استفادتنا من تراثنا الفكري والديني، وما خلفه المسلمون. منذ عصر النهضة إلى الآن ظلت الأيديولوجيا هي المهيمنة على تفكيرنا وممارستنا في مختلف جوانب الحياة. ومن يزعمون أنهم باحثون ومفكرون ومؤرخون لا علاقة لهم بالعلم، ولا يمكنهم الانخراط في تجديد الفكر العربي عامة، والديني خاصة، لأنهم يحملون تصورات جاهزة عن العالم، ولا يطرحون السؤال العلمي، ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا.
ألف أبو علي اليوسي (1102هـ) كتابا سماه «القانون في أحكام العلم، وأحكام العالم، وأحكام المتعلم» لم يحقق هذا الكتاب للأسف إلا في سنة 1998. وأعتبر هذا الكتاب كتابا في «الإبستيمولوجيا» كما نسميها اليوم. فهو يتناول قضايا مختلف العلوم الدينية والدنيوية، مستفيدا من مختلف الأدبيات العربية السابقة، مقدما آليات وإجراءات التفكير العلمي، ومتوقفا على كل العلوم التي كانت سائدة مصنفا إياها، ومبينا مختلف ما يتصل بها. وأدعو على اعتماده في مقررات تعليمنا. في الفصل العاشر: «في مدح الإلحاح على طلب العلم، وأن مفتاح العلم السؤال» يسرد ما يلي: «روي أن رجلا في زمان النبي (ص) أصابه جرح، وأصابه احتلام. فأُمِر بالاغتسال، فمات. فبلغ ذلك النبي (ص) فقال: قتلوه. قتلهم الله. ألم يكن شفاء العيِّ السؤال؟». وقال بعض السلف: «العلم خزانة. مفتاحها السؤال». وعن ابن مسعود: «زيادة العلم الابتغاء، ودرك العلم السؤال، فتعلم ما جهلت، واعمل بما علمت».
يبدو لنا من خلال الحديث النبوي «شفاء العيّ السؤال» ما يؤكد مساهمة الإسلام في بناء صرح حضارة متميزة.








