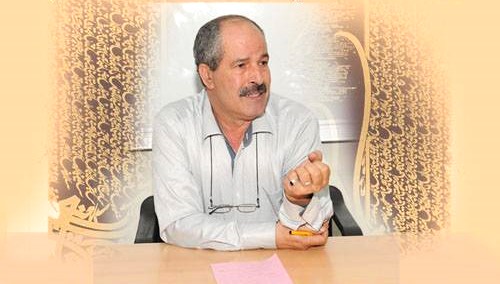
كلما حل موسم دراسي وجامعي جديد تكثر الأحاديث عن الدخول ومشاكله وإكراهاته، ونجدنا نعاود ما قلناه في سنوات خلت، ولا تتغير سوى نبرات أصواتنا، وقد تغيرت مع الزمن. تتضاعف الأعباء والتكاليف، ولا تزداد مع الزمن إلا بروزا. فالآباء يرزحون تحت عبء ثقيل، وهم يفكرون في روض الأطفال، ونوعيته، ومصاريف التسجيل، وواجبات الشهر والنقل، التي صارت تقدر بآلاف الدراهم. أما من حصل على البكلوريا فيُخمِّم أين سيسجل، وما هي آفاقه؟ ومن حصل على الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه، فوراءه البحث عن المستحيل.
تناقش قضايا الهدر المدرسي، والاكتظاظ في المدينة، والقاعة المتعددة المستويات في البادية، وخصوصية التعليم الخاص وتكاليفه التي باتت حملا ثقيلا. وعلاوة على ما يتراكم مع السنوات والعقود من مشاكل تتصل بإصلاح ما أبقاه «الإصلاح» السابق من فساد، تقدم مبادرات جديدة تقطع مع ما مورس منذ أمد بعيد، في دورات لا تنتهي.
إن تواتر هذه القضايا، وتكاثر هذه المشاكل كل سنة دراسية جديدة، يبين لنا بالملموس أن قاطرة التعليم عندنا ما تزال متوقفة على السكة، وأنها لا تتحرك البتة. وإذا ما تحركت قاطرة التعليم في العالم المتقدم، ونحن نعاينها من قاطرتنا توهمنا أنه هي التي تتحرك، وعندما تغادر تلك القاطرة المحطة ندرك أننا ما نزال وقوفا، ولم نبرح مكاننا، وأن الآخرين يتقدمون. فأين المشكل الجوهري؟
ما أكثر شُعَب هذا المشكل الجوهري التي تتوالد باستمرار لأنها تراكمت مع السنين والعقود، وتزايدت لأنها لم تحل في إبانها، وصارت تضاف إلى ما بات يفرض نفسه مع الزمن، وقد أصبحنا نتحدث الآن عن الذكاء الاصطناعي. لم ننجح في تعميم التعليم، فطبقنا التخصيص فلم يؤد إلا إلى مزيد من تفشي أنواع جديدة من الأمية. فشلنا في التعريب، وعدنا إلى الفرنسة، فظهر لنا أنها هباء، وها نحن نرى الحل في اختيار النكلزة؟ وقس على ذلك في مختلف القضايا المتصلة بالتكوين، وبالمقررات والمدخلات والمخرجات، والبحث العلمي وسوق الشغل، وغيرها من مشاكل التسيير والتدبير. يمكن أن تتعدد مداخل البحث عن شعب المشكل الجوهري أو البنيوي. لكن تعليما بهذه المواصفات التي يسود فيها الارتجال، والتسرع، والتنجيح، والفوقية، وعدم إدماج المهتمين بالتعليم في أي تجربة إصلاحية جديدة، يفرض علينا السؤال التالي: ما هي نوعية الأساتذة أو المعلمين الذين يضطلعون بالتعليم في مختلف حقب الإصلاحات، إذا ما كانوا وليدي هذا التجربة الإصلاحية أو تلك؟.
إن غياب التفكير في المدرس الجيد أدى إلى تكريس التخبط الذي نعيش فيه، إذا كانت عند المدرس مشاكل معرفية وتربوية، وغير قادر على مواكبة ما يجري على الصعيد التربوي والمعرفي أنى له أن يضطلع بدوره في ممارسة التعليم والتربية والتهذيب؟ من يدرس في التعليم الخاص في مختلف أسلاكه من الروض إلى العالي؟ لماذا نتحدث عن مدارس الدعم المدرسي، التي صارت في كل الأحياء حتى الشعبية منها؟ لعل سؤال المدرس الذي أهملنا التفكير فيه بعدم تطوير المراكز التربوية الجهوية، والمدارس العليا للأساتذة، وعدم تطويرنا لتجربة «تكوين المكونين» لمن يشتغلون في الجامعة أدى إلى كل المساوئ التي بتنا نتحدث عنها وهي تتصل قبل تحصيل المعرفة بإتقان لغة التدريس، سواء كانت عربية او فرنسية أو إنجليزية أو غيرها، وقد أصبحت مشكلة تواجه طلبة الدكتوراه.
عندما أطلع على فهارس الشيوخ في التجربة المغربية، على سبيل التمثيل، أو على ما خلّفه لنا هؤلاء الشيوخ الذين درسوا في جامع القرويين أو الزوايا عندما كانت متألقة في تاريخ المغرب، أجد كل شيخ يعدد العشرات من شيوخه الذين درس عليهم، وأجازوه في مختلف أصناف العلوم التي درّسوها له، أو حفظوه إياها، أو أملوها عليه، وكلهم أعلام في تخصصاتهم. وفي الوقت نفسه أجد في تراجم هؤلاء الشيوخ عشرات التلاميذ، الذين يذكرونهم بأسمائهم، وقد صاروا بدورهم شيوخا يواصلون ما ترسخ في ممارستهم التعليمية والتربوية. كان الشيخ معلما ومربيا في الوقت نفسه. كان يمزج العلم بالعمل، ولم يكن الهدف فقط هو نقل المعلومات إلى التلميذ، ولكن كان أيضا يسلك به منهجا لتطوير ذاته ليترقى في الطريق. كان الشيخ يعلم التلميذ، وفي الوقت نفسه يكوِّن المريد. وهذه العلاقة بين الشيخ والتلميذ والمريد هي التي جعلت الهوية الثقافية المغربية التاريخية متواصلة حتى في أحلك الظروف التاريخية وأصعبها، وعلى المستويات كافة. كانت هذه الهوية ذات أصول في الثقافة العربية ـ الإسلامية، وساهم المغاربة فيها مساهمة جليلة وهم يشاركون في تطويرها حتى جاء الاستعمار، فخلق نوعا من الهجانة في تعليمنا وتكويننا، ولم نكن قط قادرين على اختيار سياسة تعليمية هي في الوقت نفسه امتداد لتاريخ، وتفاعل مع ثقافة العصر الحديث. فمن منا شيخ صار له تلاميذ؟ أرى أن هذه هي المشكلة الجوهرية. فلا تعليمنا عتيق يكوِّن التلاميذ ولا هو عصري يخرِّج الطلبة. إنها التبعية التي تجعلنا غير قادرين على تكوين الشيوخ ـ العلماء، ولا التلاميذ ـ الطلبة.








