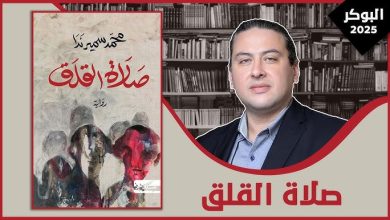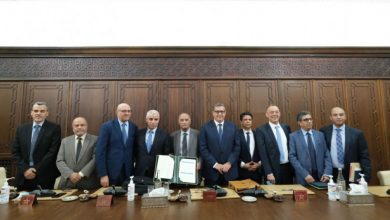علاقة الإنسان بنفسه، وبغيره، وبمحيطه الطبيعي الذي يعيش فيه ثابتة على مر العصور، وستظل متواصلة لا تغيير فيها أبدا على مستوى النوع، وإن اتخذت صورا مختلفة تخضع للتطور التاريخي في مسيرة الحياة البشرية، ما لم تقع قطائع تنهي ما تراكم عبر الزمن بكيفية نهائية. إن مختلف أصناف التفكير التي مارسها الإنسان متغيرة بحسب ما يراكمه من معلومات ومعارف ينبني بعضها فوق بعض، لكنها في الجوهر ظلت ثابتة في العمق. يعود السبب في ذلك إلى أن الأسئلة الجديدة التي يطرحها الإنسان تظل محملة بالأسئلة الأبدية التي يطرحها، والتي تظل إجاباته عنها قيد ما يتحقق في الزمان من تبدلات وتغيرات. وقد تدفع هذه التحولات إلى استعادة “النماذج” القديمة لتقديمها بديلا عن كل اشكال الإخفاق التي يعرفها العصر الذي نعيش فيه.
تربيت وجيلي ثقافيا وفكريا على الإيديولوجيا الغربية التي تأسست في مناخ فلسفي واجتماعي مبني على المصلحة أو السلطة التي تميز بين الناس بتقسيمها إياهم إلى طبقات أو فئات اجتماعية ترتبط بالحياة على أسس مادية محضة، وغير مهتمة نهائيا، بل وضد الأسس الثقافية أو المعرفية الضرورية للإنسان لتحقيق ذاته بمنأى عن أي شكل من أشكال التبعية. فكان بذلك تعطيل مقوم هام من مقومات إنسانية الإنسان التي لم نكن نلتفت إليها، لأننا كنا نرى فيها البديل الذي يخرجنا من التخلف ويحقق لنا صورة المجتمع الذي نريد، لا سيما وأن الفكر الإسلامي الذي كنا نتعامل معه لم نجد فيه إلا ما يدعو إلى الرجوع إلى الماضي ليكون المستقبل.
لقد مارسنا في السبعينيات موقفا ضد التبعية للغرب الرأسمالي. ولكننا عملنا على محاربته بتبني تبعية أخرى للفكر الاشتراكي لأنه كان يتخذ موقفا من الإمبريالية والغرب بصورة عامة. لقد استبدلنا تبعية بأخرى، ولم نتحرر من التبعية نهائيا. وحتى الذين تبنوا السلفية للتحرر من الغرب بنظاميه لم يتحرروا بدورهم من التبعية لفكر إسلامي ظلوا يرون فيه النموذج لما ينبغي أن نكون عليه من أجل التقدم. فكانت كل أشكال التبعية للغرب الرأسمالي، أو الاشتراكي، أو للتراث الإسلامي، دليلا على عدم القدرة على استيعاب ما معنى أن نتحرر من أي تبعية. ولما فشلت كل هذه المشاريع في تاريخنا الحديث بدأنا تحت تأثير “الهجانة” التي فرضتها العولمة، وفي مختلف ما جادت به قريحة الفكر الغربي لإدامة الهيمنة، وتطوير أشكال التبعية له باسم شعارات الديمقراطية والحداثة وما بعدها، وغيرها من الشعارات، نرى في الهوية والعرقية والطائفية، على مستوى الوطن العربي، وما يدخل في نطاقها من أدبيات، البحث عن تبعية جديدة ترى في الهويات والعرقيات والطوائف ما يمكن أن نستدعيه للخروج من إسار “التبعيات” القائمة، عبر خلق تبعية جديدة لتاريخ موغل في القدم، ولهويات نرى فيها المخرج، ونعمل على “استعادتها”، من خلال تقديمها نموذجا مختلفا للخروج من أشكال التبعيات المهيمنة.
يمكننا اختزال كل تاريخنا الحديث في ممارسة “التبعية” إما للماضي الإسلامي المجيد، أو للحاضر الذي فرضه الغرب، والآن صار التلويح بالماضي ما قبل الإسلامي من لدن بعض الدعوات التي باسم الحداثة، وما بعدها تفكر بالطريقة السلفية عينها، وهي تمجد أساطير ومعتقدات ما قبل تشكل التاريخ الإسلامي. فكيف يمكننا التخلص من كل أشكال التبعية، قديمها وحديثها؟ ونكون أبناء العصر الذي نعيش فيه مستفيدين من كل منجزات الفكر الإنساني؟ قبل الجواب عن هذا السؤال نطرح آخر نراه مدخلا للانتقال إلى الجواب عن هذا السؤال، وهو: لماذا لا يستطيع التابع أن يتحرر؟
يتضمن الجواب عن هذا السؤال ثلاثة افتراضات نسوقها على النحو التالي: إما لأنه يريد أن يظل تابعا، وهو يرى استحالة الخروج من التبعية لأسباب لا حصر لها. وإما لأنه لا يفكر في كيف يستطيع ألا يكون تابعا. وإما، أخيرا، أنه يدعي رفض علاقته مع التبعية، ولكنه في الوقت نفسه يكرسها بادعاء أن ما تحقق في المجتمعات التي تفرض عليه تبعيتها هي “النموذج” الذي عليه أن يسير عليه للخروج من التبعية؟ وبين الإرادة في الإبقاء على وضع، وعدم القدرة على التفكير في الخروج منه، وادعاء رفض التبعية مع قبول مستلزماتها، تكمن العلاقة التي ترسخت زمنيا بين التابع والمتبوع. أختزل تلك العلاقة في ثنائية: اللاعب والجمهور.
تفرض هذه الثنائية نفسها في واقعنا الحالي الذي صارت فيه العلاقة بينهما تتخذ أبعادا كثيرة تجعلها بشكل ما تنويعا عن العلاقة التقليدية بين العبد والسيد، والشريف والعامي، والبرجوازي والعامل، والمستعمِر والمستعمَر وغيرها من الثنائيات التي عرفت في تاريخ البشرية. لا فرق هنا بين اللاعب السياسي، والرياضي، وغيرهما. وسواء كان هذا اللاعب في الواقع الطبيعي أو الافتراضي مع الثورة الرقمية. لقد صرنا نتحدث عن “المؤثر” تماما كما الحديث قائما عن الشيخ، والليبرالي، وداعي التقنية، كما في تشخيص العروي. فاللاعب هو المتبوع الذي يتبعه الجمهور أينما حل وارتحل، يصفق له في إنجازاته وانتصاراته، ويبرر أخطاءه وانكساراته، ويهاجم خصومه، وينتصر لمن يخاصمه. وكل هذه المواقف والرؤيات تتأسس على قاعدة أن اللاعب “نجم”، وأن الدوران في فلكه “اعتقاد” تتحقق من خلاله “ذاتية” الجمهور لأنه يرى فيه ما يفتقده في حياته، أو يريد أن يكون عليه، وليست له القدرة على بلوغه. إن اللاعب المتبوع يقوم بالدور الذي يحلم به التابع، ولا يستطيع الفكاك من هذا التصور حتى وإن كان يغضب أحيانا من اللاعب، أو يعبر عن سوء تقديره له في بعض الحالات التي يراه فيها لا يجسد طموحاته على النحو الذي يرضيه. ولكنه مع كل ذلك يظل يرى فيه النجم الذي يقتدي به في حياته العملية والفكرية حين ننقل صورة هذا اللاعب هنا من مستواها العادي إلى المستوى الأرقى الذي يصنع السياسات، ويرسم خرائط المجتمعات.
ما رسنا التبعية للفكر الغربي الحديث، وحاربنا التبعية للغرب باسم الإسلام، وها نحن ندعي مواجهة كل أشكال التبعية الآن بالبحث عن نماذج موغلة في الزمن. في كل هذه الممارسات كنا بُعداء عن “روح” الفكر الغربي لأننا لم نفهم جيدا الروح التي تأسست مع عصر الأنوار، والتي كان مدارها على تحقيق “الرفاه” للإنسان (الدنيا)، بصورة خاصة، وبقينا نجتر “شعارات” (الحداثة) من الفكر الغربي دون استيعابها. كانت تلك “الشعارات” تُرفع لمواجهة “شعارات” مناقضة رفضت الفكر الغربي لأنها رأت نموذج مستقبلها كامنا في الماضي (الأصالة)، وهي بالطريقة نفسها لم تستوعب روح الإسلام، فوقفت عند حدود الشعائر، ولا تتعامل معها في نطاق رؤيتها للإنسان في مختلف أبعاده الحياتية، وخاصة ما اتصل منها بالبعد الروحي الذي لا يتنافى مع البعد المادي (الدين والدنيا). فلم نحقق الأصالة ولا المعاصرة. وها نحن باسم الحداثة نتبنى البديل في الدفاع عن “النموذج” الذي نراه كامنا فيما قبل التاريخ (الطائفية والعرقية).
إن كل الأسئلة التي تم طرحها في كل تاريخنا الحديث (منذ مرحلة الطباعة) إلى الآن (مع الرقامة) ظلت ترى النموذج في “اللاعب” المتبوع، أيا كانت صورته. وكانت علاقتنا به مبنية على الأهواء لا العقل. وليست الأهواء هنا سوى “الإيديولوجيا”، وكانت صراعاتنا إيديولوجية فقط. عندما يتخلص الجمهور منها، يتحرر من التبعية للاعب لأنه سيتخذ موقفه على أساس ما يفعل، وليس على ركيزة أنه “النجم” الذي يدور في فلكه.