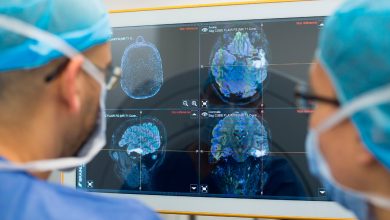انطلقت هذه الأيام حملة للتسجيل في مدارس البعثة التعليمية الفرنسية بالمغرب بعد أن بلغ عددها لحد الآن 46 مؤسسة موزعة على خريطة الوطن من طنجة إلى العيون والداخلة، وتجاوز عدد تلاميذها 47 ألفا، وأعلن عن تدشين مؤسسات أخرى ستفتح أبوابها في الموسم القادم بشراكة مع شخصيات مغربية نافذة. هذا فضلا عن سلسلة مدارس التعليم الكندي والبلجيكي المُستعملة للغة الفرنسية .
وبهذه المناسبة أذكّر بما يلي:
لا يمكن أن يكون هنالك أي إصلاح حقيقي بعيد الأهداف واضحِ الرؤية لمنظومة التعليم ببلادنا في ظل ما نشهده من توسّع رهيب لبُؤَر التعليم الأجنبي التي تزداد تمدّدًا وتضخّمًا وانتشارًا يومًا عن يوم، رغم التحذيرات والتحفظّات المتكرّرة التي طالما عبّر عنها كثير من الباحثين والمختصين بالمجال التعليمي والتربوي والغيورين على بلادهم الذين ما فتئوا يطالبون بوضع قيود تُوقف تنامي ظاهرة هذا النمط التعليمي وتقلِّل من أضراره التي تهدد مستقبلنا الثقافي ووضعنا اللغوي. ولا أتحدث هنا عن مراكز تعليم اللغات الأجنبية، فهذا لا علاقة له بموضوع حديثنا. وإنما نتحدث بصفة خاصة عن مؤسسات البعثات التعليمية الأجنبية الموروثة عن مرحلة الحماية بمناهجها وتوجّهاتها الكبرى ولغتها وأهدافها المرسومة منذ ذلك الحين، والتي نلاحظ تمدّدها وتوسّع أنشطتها ومُنشآتها داخل بلادنا باستمرار، وبشكل يفيد ويؤكد أنه إذا كان الاحتلال الاستيطاني أو الظاهري قد غادر سنة 1956 فالاحتلال اللغوي والثقافي، ظل يعمل عمله ويركِّز وجوده ويعمِّق أنفاقه ومساربه في خلايا المجتمع بشكل لافِت ومؤثِّر.
على أن الخطورة الجديدة التي أضيفت إلى ما كان معروفًا من سلبياته سابقًا، هي أن هذه السلسلة من مدارس البعثة التعليمية الأجنبية لم تعد، تكتفي بنفسها وتقوم بذاتها وتقتصر على جهودها الخاصة، بل أصبحت، من جهة أولى تعمِّق نشاطها بعقد شراكات مع القطاع الخاص المغربي والأجنبي وشخصيات نافذة في الدولة ومحتمِية بالسلطة، لتوسيع مجالات استقطابها وفتح مؤسسات تعليمية ضخمة بتجهيزات مُغرِية، مع الإبقاء على تبعيتها للدولة الأجنبية في إدارتها ولغتها وأهدافها ومناهجها وتوجّهاتها، كما أصبحت من جهة أخرى، بمثابة قاطرة لنوع من التعليم المغربي الخاص تجرّه وراءها فيطبق مناهجها ومقرّراتها ولغة تدريسها، ويؤدي دور الوَصيف أو الرّديف الذي يحذو حذوها ويسير في ركابها ويكمِّل دورها ووظيفتها. وهذه الظاهرة الجديدة بوجهيها حرية بالدراسة والتأمل والتحليل. فإذا كانت النُّخَب الوطنية المخلصة في الماضي قد أولَت أكبر عنايتها لفتح مدارس أهلية ورسمية مجّانية هدفها الأول تعميم التعليم ونشره على أوسع نطاق لتكوين أجيال واعية وكفاءات قادرة على خدمة وطنها بإخلاص وأمانة، معتزّة بقيم بلادها وأمّتها، مرتبطة بتاريخها وحضارتها، صالحة، فإن الجيل الجديد من النخب المسلّحة بالمال والنفوذ والسلطة، أصبح يعمل في اتجاه مضاد، فيساعد الاحتلال اللغوي على ترسيخ وجوده وتوسيع نفوذه، من جهة، ويعمل من جهة أخرى على تحويل قطاع التعليم إلى مشاريع تجارية خاصة تُستثمر فيها الأموال وتصبح مجالاً خصبًا وسهلاً لمراكمة الثروة وتكديس الربح السهل دون اكتراث بسوء الأهداف ولا سؤالٍ عن المُخرَجات والمآلات، ولا مبالاةٍ بالأضرار الكثيرة الأخرى التي يأتي على رأسها تحطيم المدرسة العمومية والقضاء عليها، وتوسيع نطاق تعليم طبقي يُفرز فئةً من المتعلمين المنفصلين عن واقع مجتمعهم وقاعدتهم الشعبية وعن هموم الأغلبية الساحقة من المواطنين ومشاكلهم ومعاناتهم، المُتعالِين طبقيًا، والمترفِّعين اجتماعيا عن غيرهم من أبناء الوطن، متشبّعين بلغة أجنبية تُضايق اللغة الوطنية المشتركة وتحاصرها في كل المجالات، وتؤسس لصراع ثقافي ولغوي ينتصر للغة والثقافة الأجنبيتين، ويفتح الباب واسعًا للنوع المستهجَن من التعدّد اللغوي العشوائي الذي تطغى أضرارُه على منافعه، ولا يكون للغة الوطنية الرسمية فيه إلا حضور هامشي باهت. وحينما يغيّر المجتمع لغته وثقافتَه فهو يغيّر معهما انتماءه الحضاري والديني والتاريخي، ومع الزمن يسقط في التبعية المطلقة للأجنبي حضارةً وثقافةً وانتماءً. وإذا كانت هذه النخب والأجيال، من المتخرجين من هذا النوع من التعليم بتكوينهم وعقليتهم وثقافتهم ولغتهم الأجنبية، هي التي يتم إعدادُها لتولّي المناصب وتحضيرها لحمل المسؤوليات، فأي مستقبل ينتظر البلاد، وأي طريق هذا الذي تسير فيه؟
لذلك أجدني، كلما مررت أمام بناية من هذه البنايات الضخمة للتعليم الأجنبي وشبه الأجنبي وما يُلحق به من تعليم تجاري على طريقته ومنهاجه، وقد غُرِست أشهرُها وأكبرها في الأحياء الفخمة بالعاصمة، ووقفَتْ أمامها عشراتُ السيارات الفارهة التي لا يتردد أصحابُها في دفع كل ما يطلب منهم من ملايين لم يتعبوا في تحصيلها، أقول لمن معي من الأبناء: ضاعت بلادك يا ولدي.