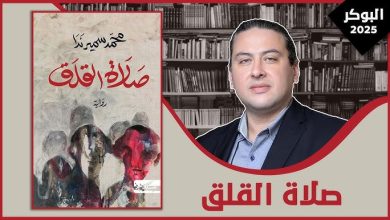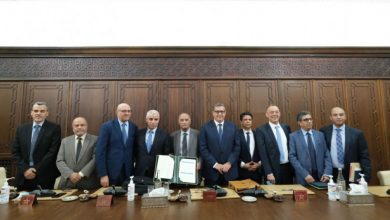ـ في استضافتها بالمجلس العلمي المحلي للمضيق والفنيدق ـ
ولا غرْو، فالأندلس تجري من فاطمة طحطح مجرى القلب والفكر ، فقد نذرت زهرة عمرها وعُصارة جهودها الجامعية والفكرية لاستعادةٍ رمزية للفردوس المفقود والحفر الأركيولوجي في ذخائره وكنوزه الأدبية والفكرية ، سائرة على منوال سلفها الأندلسي ابن بسام صاحب (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) ، ومستأنفة جهود أستاذها الباحث المحقق الأندلسي الدكتور محمد بنشريفة .
ولا غرْو ثانية ، فهي حفيدة ُفاتح الأندلس الأمازيغي – الريفي طارق بن زياد ، ومن سلالته المباركة التي شدّت على العُروة الوثقى بين العَدْوتين الجارتين المغرب والأندلس ، كما حافظت على روعة اللقْيا بين العربية والأمازيغية .
من هنا ظلت فاطمة منذ أن تفتّح منها الوعي وانقدحت قريحتها الأدبية وموهبتها البحثية ، مسكونة بنوستالجيا أندلسية عميقة لا تغادر وجدانها . ذلك ما تجلّى في مجمل مؤلفاتها وأعمالها .
– الشعر في عهد المرابطين بالأندلس والمغرب
– الغربة والحنين في الشعر الأندلسي
– دراسات في الفقه والتصوف بالأندلس والمغرب ، ابن العربي والبادسي نموذجا
وبحوث مُوازية منشورة في الدوريات والمجلات .
هذا إلى مشاركاتها ومساهماتها في المحافل الجامعية والملتقيات الفكرية ، شرقا وغربا ، بدون جلبة إعلامية وزفّة إشهارية .
ولعلّ أطروحتها الجامعية المتميزة (الغربة والحنين في الشعر الأندلسي) عنوان دال على هذا الحنين النوستالجي – التاريخي إلى الأندلس . حنين من القلب ناطق بلسان الفكر والمعرفة .
وفاطمة طحطح لذلك ، وخلافا لكثير من الباحثين والباحثات ، ليست مجرّد باحثة تطوي أوراقها وتمضي ، بل هي باحثة تنزع عن مشروع واستراتيجية مرسومة ومتّئدة .
باحثة عاشقة لبحوثها مُنتشية بأسئلتها وموضوعاتها .
وهذه خصلة تكاد تكون غائبة في كثير من بحوثنا الجامعية والأكاديمية التي ترنو إلى ما وراء الأكَمة . إلى فائدة وعائدة البحث .
والبحث العلمي كالعمل الإبداعي ، لا يعطيك بعضَه حتى تعطيه كلك .
أعرفُ فاطمة طحطح منذ سنوات التحصيل الجامعي بكلية الآداب – ظهر المهراز بفاس ، في طلائع الستينيات من القرن الفارط .
كانت كلية ظهر المهراز ابّانئذ ، فتيّة بهيّة تجمع نُخبا من الطلاب والشباب من كل فجّ مغربي . وكان المغرب الخارج من إسار الاستعمار يخرج أيضا وبتؤدة واحتراس من إسار السيطرة الذكورية والزمن الأبيسي .
وكانت طالبات ظهر المهراز الفرائد – الخرائد وفاطمة إحداهن وواسطةُ عقدهن ، يُحْصين على أطراف اليد . كُنّ نُجيمات الحي المضيئة بوجوههن الصِّباح وذكائهن اللمّاح ، كما كنّ ندائد ومُنافسات لجمع المذكر السالم في مدرّجات المحاضرات ، أمام أساتذة نوابغ من مغرب ومشرق .
وكما جمعني الحيّ الجامعي بفاس بالأستاذة فاطمة ، كان يجمعنا السفر أيضا أيام العطل من فاس إلى أكنول بنواحي تازة ، حيث كان والدي ووالد فاطمة قاضيين مرموقين في المنطقة، من الألى السادة النّجب ، وكانت عائلاتانا متجاورتين مُتواشجتين .
ألا حيّ الله ذاك الزمكان الجميل الأصيل ، وسقى ثرى أحبابنا الراحلين الساكنين في القلوب.
إذا ذكَرواأوطانهم ذكّرتهم / عُهودَ الصبا فيها فحنّوا لذلكا
ومن كلية ظهر المهراز بفاس وكلية الآداب بالرباط تاليا ، طلعت فاطمة طحطح باحثة أندلسية مُقتدرة سارت بذكرها رُكبان الشرق والغرب بلا جلبة ، ومُنشئةَ أجيال من الباحثين والباحثات ازدانت بهم المنابر الجامعية عبر طول وعرض الوطن .
هي من جيل الريادة الجديدة من الباحثات المغربيات غداة الاستقلال ، ومن القلّة المباركة من تاء التأنيث اللاّئي خُضن غمار البحث الجامعي المغربي في مجال أدب الغرب الإسلامي .
وأظنّها مع رصيفتها ورفيقتها الدكتورة نجاة المريني ، سيدتيْ وفارستي ْحلبة ورهان .
نجاة في مجال الأدب المغربي وفاطمة في مجال الأدب الأندلسي – المغربي ، أو ما اصطلح عليه بأدب الغرب الإسلامي .
وحين نفتحُ العين على هذا المفصٍل الزمني – التاريخي من المغرب الآتي من الاستعمار إلى الاستقلال ، لا نرى إلا أسماءَ نسويةً يتيمة تلوح في سماء المشهد الثقافي المغربي كالخيوط الأولى للفجر .
كان ثمة ريفية باحثة رائدة في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي من عٍترة علم وأدب ونسب ، هي آمنة اللوه . وعلى مقربة زمنية منها ، كانت مليكة الفاسي تدق الجرس . وبُعيد الاستقلال مباشرة لم يكن يُخالط كورال الأدب المغربي – الأبيسي سوى تاءاتِ تأنيث تُعدّ على أطراف البنان ، خناتة بنونة – زينب فهمي (رفيقة الطبيعة) – مالكة العاصمي .. تلك بشائر الربيع الأدبي المغربي النسوي .
تلك أصواتٌ جريئة جديدة عزفت خارج الكورال السائد . خارج السّرب لكن من عُمق السرب .
وقد اختارت فاطمة طحطح أن تخوض في مجال صعب المراس مُعتاص المركب ، هو مجال التراث الادبي والفقهي والصوفي للغرب الإسلامي .
وفي كتابها الأخير وليس الآخر ، (دراسات في الفقه والتصوف بالأندلس والمغرب ، ابن العربي والبادسي نموذجا ) تذهب بعيدا وقريبا في آن ، فتعقد مقارنة فكرية – تاريخية بين عَلمين وعُنوانين من التراث الفقهي التصوّفي في الغرب الإسلامي ، وهما ابن العربي المعافري وعبد الحق البادسي الغرناطي .
ويشكّل الكتاب مُرافعة فكرية وتاريخية عن الهويّة المالكية – الوسَطية العريقة للمغرب والأندلس ، من خلال مُساجلة ابن العربي المعافري للإمام أبي حامد الغزالي من خلال كتابه (العواصم من القواصم ) ، ومرافعة فكرية وتاريخية مُوازية عن الهوية الثقافية الأمازيغية – الريفية المهمّشة من خلال كتاب عبد الحق البادسي ( المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصُلحاء الريف) الذي انتقد فيه المؤرخين المشارقة على مرورهم مرّ كرام على الديار المغربية . كما تصدى فيه بخاصة لابن الزيات التادلي في كتابه (التشوّف إلى رجال التصوّف) الذي اهتم بصلحاء ومتصوّفة جنوب المغرب ، وضرب صفحا عن صُلحاء ومتصوفة الشمال .
وجاءت هذه الباحثة الريفية – الأندلسية فاطمة طحطح ، لتنفض الغبار وتُعيد الاعتبار ، من خلال جولة تاريخية – حفرية في رُبوع الريف . إحقاقا لحقائق تاريخية لا انصياعا لنعرات شوفينية ، ما أنزل الله بها من سلطان .
وقد كانت باديس الريفية في تلك العقود الزاهرة ، حاضرة ثقافية وحضارية مُشعّة ، وفيها يقول لسان الدين بن الخطيب:
عسى خَطرةٌ بالرّكب يا حاديَ العيس / على الهضْبة الشمّاء من قصر باديس
لنظفرَ من ذاكَ الزّلال بعَلّة / وننعمَ في تلك الظلال بتعريس
هنا نلمس هذا البُعد الاستراتيجي العميق الثاوي في ثنايا وطوايا هذا البحث المُشرع على الأندلس والمغرب والمشرق العربي في أرْيحية فكرية عليلة الهواء وارفة الظلال كما لو أنها صدى عائد من أيام الأندلس .
هذه بعضُ السمات الأدبية والفكرية في شخصية الأستاذة الباحثة فاطمة طحطح ، والتي أوجزتُها في عنوان هذه الكلمة / أندلسية من الريف ، أو ريفية من الأندلس ، سياّن .
ولا أريد أن أغادر هذه الكلمة – الشهادة ، دون أن أحيي وأجلّ رفيق طريق فاطمة طحطح وشريك حياتها ، أخي وصديقي الباحث الجامعي الدكتور أحمد الطريسي أعراب . والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات . وإذا كان وراء كل عظيم امرأة كما قيل ، فإن هذا “الكوبل” الأدبي ، يُظهر الوجه الآخر للمعادلة ، وراء كل عظيمة رجل .
فلهما معا ، نصفّق ابتهاجا وندعو لهما بدوام الصحة والعمر .