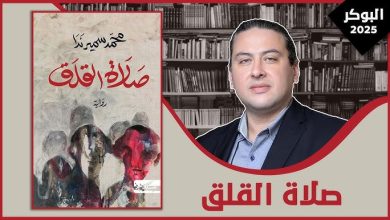1 ـ أسوأ مصطلح للتعبير عن الميتافيزيقا بالعربية، وربما حتى في لغات أخر، هو مصطلح “ما وراء الطبيعة”، عوض “ما بعد الطبيعة”. والحال أن ثمة بون شاسع بين الماواء وبين المابعد. أي ما بين ما هو مفارق للوجود على الإطلاق، وبين ما هو فقط تفكير في ماهية الوجود عينه، لا في شيء آخر وراء هذا الوجود. المابعد ينتسب للشيء عينه، أما الماوراء فهو ينتسب لشيء ما، يفتقد لماهية الوجود وليس من طبيعته، بل هو من طبيعة أخرى ليس لها وجود واقعي إلا من خلال ما قد ينتسب للخيال، أو قد ينتسب للذهن وحسب، بدون أن يكتسب صيغة مفهومية عن الكينونة كتعبير ميتافيزيقي صميم عن الوجود عينه.
2 ـ الفرح غير قابل للاستجداء، كونه حصول ناتج عن الاقتدار على فرح مستحق بالفعل، وليس ناشئا عن مجرد تمن لفرح موهوم. أما الحزن بما هو حزن فهو تحصيل حاصل عجز عقيم. لذلك يمني العاجز نفسه، دائما بفرح زائف، هو بمثابة تعبير عن وهم ينتعش بتمني الفرح. لهذا لا يدرك الحزن الفرح، مادام عجزا عن الفعل، وما دام الفرح ينتسب للاقتدار وليس قط لمجرد تمن ناشء عن عجز موكول للعدم.
3 ـ إذا استطعنا التحكم في الذات، فبإمكاننا أن نتحكم في العالم، وبما أننا لسنا جميعا نمتلك هذه الإمكانية، فإن العالم يكون منفلتا عنا. وهذا هو مكر التاريخ الذي يقود العالم نحو الوجهة التي قد تسود فيها نزعة إمكانية التحكم في الذات، فيكون العالم في متناولنا جميعا، ليس كتاريخ وحسب بل وكمصير لإرادة الاقتدار؛ أو قد تسود فيها نزعة شاردة، فيكون العالم في مهب ريح العدم، حيث تنعدم قيمة الوجود، ويغدو التعديم وسيلة لإثبات رغبة زائفة على التحكم في العالم برمته.
4 ـ الاقتدار لا يعني قط إرادة تغيير الواقع مباشرة، كما لا يعني قط العجز المحض عن تغييره؛ إنه يعني فقط القدرة على تحمل الواقع، ككيفية لمقاومة الوجود الزائف. لهذا لا أسف على واقع لا نستطيع تغييره مباشرة بمجرد الفكر، وإنما الأسف على فكر يتوهم أنه قادر على تغيير كل شيء بمجرد تسريع انفعالي وعجلة طيش متهور . وهذا معناه أن الاقتدار على التحمل إنما هو أسلوب في الحياة على منح القيمة والمعنى لفعل الإرادة في أفق الممكن والمستطاع، أي في أفق القدرة على التحمل، أو على حمل الوجود كما هو، وفي أفق الزمان من حيث هو قدرة على جلب الوجود إلى الكينونة بكيفية غير مباشرة، أو بكيفية لا تستعجل التغيير في ذاته، بقدر ما تتأهب لاستجماع القوى لا على بلوغ التغيير كغاية في حدذاتها، وإنما من أجل تحقيق كمال أعظم، بما هو وحده غاية الكينونة. لهذا لا تحب الكينونة التغيير في حد ذاته، بقدر ما تحب هذا الكمال الأعظم الذي يتجلى فقط من خلال الاقتدار على تغيير العالم، كإمكانية لإبداع العالم.
5 ـ في الفرق بين العدم الجذري وبين العدم العارض.
العدم من حيث هو عدم ليس محضا على الإطلاق، كون العدم لا يوجد إلا على نحو منطقي، لأن الوجود إن وجد أنطولوجيا لكان وجودا بعينه، ولكان هو الأنطولوجيا عينها. والحال أن العدم ليس قط وجودا بذاته، بل هو عدم بغيره أي بالوجود الذي هو عارض فيه، ككيفية لنمط وجود الأشياء التي في الوجود. لهذا ليس العدم قط موجودا بذاته ولذاته إلا لأنه عارض في الوجود كأثر لزمانية الوجودات القابلة للكينونة أو الموت، للكينونة كنمط لحياة عابرة، أو كموت عارض في لعبة الوجود من حيث هو أفق لتكرار الوجود.
أما العدم الجذري فهو ليس سوى المقابل الموضوعي للشر الجذري الكامن في الإنسان وحده، من حيث هو سعي بئيس لتعديم الحياة، وتطهير الغير من الوجود، وإغراق العالم في مستنقع الجريمة النكراء. وهذا معناه أن عدما جذريا لا ينبعث من الوجود من حيث هو وجود غير قابل للعدم، ولكنه ينبعث فقط في كل كيان بغيض لا ينتسب للوجود إلا من حيث هو نمط كراهية لفسحة الوجود الممنوحة لكل البشر على حد سواء.
6 ـ الأفعال أبلغ من الأقوال.
أو هكذا تتحدث الحياة فيما وراء كل منطق للكلام كأسلوب صوري لمبدأ هوية فارغ من المعنى. وهذا معناه أن الكلمة لا تساوي الكلمة عينها، إلا صوريا وحسب، بقدر ما تساوي الفعل من حيث هو كلمة من أجل حدث من توقيع كائن مقتدر على الوجود، أو من حيث هو فعل يجلب الكلمة إلى المجال الخاص للحدث الذي تتعين به وفيه الكينونة. فلا شيء يكون بمجرد الكلام، كعالم سحري لا ينتسب لواقعة الوجود، بقدر ما ينتسب لعدم خالص، كونه خال من الفعل. وكل كلام يخلو من الفعل هو كلام أجوف فارغ من الحدث. وهذا معناه من جهة أخرى لاصورية، أن الكلمة إما أن تساوي الفعل كحدث، أي أنها تساوي حدثا يتحدث عن الكينونة، وإما تساوي كلمة لا تعدو أن تكون كذلك هي عينها، فلا تكون سوى المعادل الموضوعي للعدم.
لكن ما الذي يجعل من كلمة ما معادلا موضوعيا للحياة؟ ما يجعل منها كذلك ليس سوى الاقتدار على الموت، لا كغاية في حد ذاته، وإنما كرهان على الوجود برمته، من حيث هو إمكانية لانبعاث حياة متحررة من عدم يتلف كل رغبة في الكلام من حيث فعل، وفي الفعل من حيث هو كلام يمتلك الاقتدار على الحياة، بما هي حياة جديرة بالعيش ككينونة حرة، وليس بما هي مجرد كلام لتمضية الوقت انتظارا لما قد لا يأتي أو لا يأتي بمحض صدفة عمياء، أو قد يأتي أو لا يأتي بمجرد الكلام أيضا، أي بمجرد عجز عن فعل لا يرقى إلى كلمة تنتسب إلى المجال الخاص بابتكار الكينونة.
7 ـ من السهل، في هذا العالم المزدوج المعايير، التلاعب بالمبادئ؛ بحيث يصبح مبدأ الدفاع عن النفس، على سبيل المثال، ليس بمثابة مبدأ لا مشروط ينبني على قاعدة العدالة، بل أصبح مبدأ عائما يتناسب وفق استراتيجية تتوزع فيها درجات الهيمنة بمقتضى مصالح إرادة الاستحواذ على الوجود برمته. لقد نتج عن هذا التعويم السافر والمفضوح تلاعب خطير بحق الدفاع عن النفس، وعلى الأخص حينما يتم الالتفاف على هذا المبدأ، كتبرير لبسط عدوان همجي على شعب أعزل، باسم الدفاع عن النفس. أي في حق شعب مظلوم لا يطالب بشيء بقدر ما يطالب بحقوقه المشروعة في الحرية والعدالة والإنصاف. ليس من الغريب بالفعل في، هذا العالم العائم الفاقد للسيطرة بمقتضى توجهات إرادة الاستحواذ أن يتم السطو على حق الدفاع عن النفس، من قبل كيانات غاصبة (قطر بها سقف التاريخ الامبريالي على الخصوص والموبوء بأعطاب الكراهية ومعاداة الشعوب ) لم تدخر جهدا في سبيل تعديم حق الغير في الوجود.
لكن إذا كان من السهل التلاعب بالمبادىء ، فإنه صار من الصعب استغباء ضمير البشرية اليقظ في كل بقاع العالم الحي، والذي لا يملك الآن سوى الاقتدار على الاحتجاج على هذا التعويم الفاضح لحق الشعوب في الحرية. وكأن الضمير الإنساني يقول بأن كل تلاعب بالمبادئ، مهما طال، فمآله نفايات التاريخ.
8 ـ تكمن مشكلة أصل الشر الجذري، في العجز عن تقاسم الوجود مع الغير. إنه ينشأ في هوية هووية متماهية مع ذاتها، أي إلى درجة تماه توقيفي يجعل من الوجود عينه وقفا على هذا الكيان أو ذاك. والكيان بهذا المعنى ليس من الكينونة في شيء، من حيث هي اقتدار على الوجود مع الغير، حيث الغير يتعين كآخر لا يختلف عني إلا بالقدر الذي يسهم فيه اقتداره على منح القيمة للكينونة؛ وإنما هو كيان ينتسب للعدم، كونه لا يرغب في شيء أكثر مما يرغب في الاستحواذ على الوجود برمته، ما دام أن هذا الوجود كما يتصوره كيانه هو وقف عليه وعليه فقط. وعن هذا المبدأ الذي نشأ في عقيدة كل كيان يعتقد أنه أحق بالوجود من الغير، من حيث هو وحده موهوب الوجود، كوجود فائق، أو ككيان يحق له وحده العيش وفق أحقية تجعل منه كيانا مختارا يعبث بمصير البشرية أو بالكينونة في أفقها المشترك كوجود بالمعية. بصريح العبارة يكمن الشر الجذري في كل كيان عنصري عاجز عن الكينونة.
9 ـ الأبرياء الذين يسقطون ضحايا الاستعمال الأعشى لقوة غاشمة، ليس لهم من سند سوى ضمير البشرية اليقظ. لذلك بقدر ما تنتهك آلة الفتك والدمار- التي تتغدى على الأحقاد التاريخية، وتنتعش من فضلات كراهية الجنس الآخر- كل الأعراف والمبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية، فإن دائرة التضامن اللامشروط تزداد اتساعا مع الضحايا التي طالتهم آلة الغدر والضغينة، من غير أي سبب موضوعي يستدعي الانتقام منهم كمسالمين عزل، سوى تلك النية المبيتة في ثنايا شر جذري، يتحين الفرصة السانحة في خضم صراع ملتبس من أجل ممارسة تطهير أو تهجير عرقي أو إتلاف لقضية شعب أعزل طالت نكبته إلى حد يخجل فيه التاريخ من نفسه. وبالقدر الذي تنحاز فيه إلادارات النافذه في العالم إلى تلك القوة الغاشمة بدون قيد أخلاقي أو شرط إنساني، فإن ضمير البشرية يزداد تضامنا في كل بقاع العالم مع شعب أعزل يتعرض منذ عقود من الزمن إلى شتى أشكال الحصار والبطش والتدمير والممارسة المنهجة لقتل عمدي يستهدف كل الملاذات الآمنة التي يستجير بها الأبرياء الذين ينشدون الأمن والسلام.
10 ـ النوايا الخبيثة، ليست خبيثة لرغبة ما في انتقام متكافىء، من البعض المعلوم موضوع الانتقام. بل هي نوايا خبيثة، لأنها تتصيد ما تعتبره أخطاء قاتلة من البعض المعلوم، للانتقام من الكل المجهول، بدافع من شر جذري، لا تحركه مجرد الرغبة في الانتقام، بل تحركه ضغينة دفينة نابعة في مبدأ أحقية زائف يستهدف الاستحواذ على الوجود برمته بالرغم عن الآخرين، أي ليس فقط بدافع نفي الآخر وتهجيره فقط، بل بدافع اجثات وجوده على الإطلاق. لسبب بسيط كون النوايا الخبيثة عاجزة على التساكن في هذا العالم الفسيح الذي يتسع للعالمين كافة. لذلك لا يرضي النوايا الخبيثة التي تشكلت في غياهب الضغينة، أن تنتقم من البعض المعلوم في أفق صراع الند بالند، بل تختار الأسوأ، أي الانتقام من براءة الوجود، حيث الوجود ليس حكرا على موجود بعينه، ولا هو أحقية للبعض دون البعض الآخر، أو دون كل مندور للتساكن والجوار، أو القرابة البشرية. وحيثما تحرك الضغينة التاريخ، لا يكون التاريخ صراعا من أجل حق في الحياة يتسع للجميع ، وإنما يكون بمثابة مقبرة للآخر، كأحقية في الوجود دون آخرين.
اعتقدنا، مع هيجل، أننا تجاوزنا مسألة الاعتراف، فإذا بنا نستفيق اليوم على صراع من أجل نفي مبدأ الاعتراف المتبادل من الأساس. حيث أن آلة الضغينة التي وقودها النوايا الخبيثة، تتحرك على نحو تقدم فيه نفسها على أنها الوحيدة الجديرة بكل اعتراف.