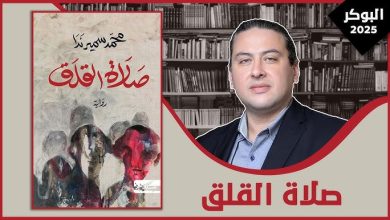1 ـ ما الكفر؟
إنه ليس كفرا بعقيدة يتبناها هذا الإنسان أو ذاك؛ ولكنه كفر بالوجود، من حيث هو وجود معطى لكل البشر بدون تفاضل قبلي، أو خيرية موهوبة لكائنات بعينها دون الأخرى.
وكل كفر بالوجود، هو كفر بالاختلاف، كون الاختلاف حال من أحوال صفتي الوجود اللتين هما الفكر والامتداد. وذلك لأن:
١- الاختلاف منتسبا للفكر، إنما هو نمط من أنماط تنوع التفكير، كاقتدار على الحق في اختيار مبادئ تنسجم مع تجربة عيش خاصة لكائنات لا تتناحر من أجل الرأي والقناعات والعقائد، بقدر ما تتقاسم تجارب الفكر، وحكمة الحياة في الأفق الفسيح للروح.
٢- الاختلاف منتسبا للامتداد هو نمط من أنماط تنوع وتعدد الكائنات التي تتقاسم الفضاء الممتد للوجود مع آخرين لا يتقاسمون القناعات نفسها، بقدر ما يتقاسمون نعمة الوجود المشترك.
لهذا كان التكفير دوما، هو نمط الغباوة القاتلة، وكان الكفر بالوجود هو الرديف الأعمى للعدم.
2 ـ ما الجمال؟
الجمال يتعين كانكشاف لكل ما هو جميل في الوجود، دون توسط المفهوم من خلال الفكر، أو مجرد التفكير المحض في الجمال. وما ينكشف كجمال، نعبر عنه تلقائيا، من خلال هذا شيء جميل، أي أننا بمجرد الإشارة يتعين ما هو جميل كحساسية معطاة لنا، من خلال إدراك حسي بكيفية مباشرة لما يشكل موضوعا لرغبتنا، فيكون بعض وليس كل ما نرغب فيه جميلا. إذ ليس كل ما نرغب فيه جميلا، فقد تكون رغبتنا في شيء يبدو قبيحا أشد من رغبتنا في شيء يبدو جميلا. وهذا إن كان يعني شيئا، فإنما يعني أن الجمال ليس يتعين بقدر تعاظم الرغبة أو تناقصها، وإنما بقدر تعاظم أو تناقص مسافة الظهور التي يبدو فيها هذا الشيء أو ذاك جميلا أو قبيحا، وما يبدو جميلا فهو جميل بالنسبة لدرجة رغبتي فيه، وقد يبدو لي بالمقابل هذا الشيء قبيحا، ومع ذلك قد أرغب فيه أو أرغب عنه. لكن ما هو الجمال بالنسبة للفكر؟ إنه ما يتعين بواسطة الفن فقط، إذ بالفن وحده يتعين الجميل على أنه هذا أو ذاك الشيء، بالفن ندرك تلك الإشارة للجميل التي يلتقطها الفكر في تحديد ماهية الجمال. في إحدى أغاني فريد الأطرش، ثمة جملة طربية دالة على هذا الأمر، تقول بالحرف جميل جمال مالوش مثال، ومعناه أن كل ما ندركه بالإشارة فريدا من نوعه إنما هو جميل. ومعناه أن الجمال هو يعز نظيره، وما عز نظيره هو النادر وكل ما هو نادر جميل وصعب سلمه، كما عبر من قبل سبينوزا في آخر جملة في كتابه الفريد الإيطيقا.
3 ـ القراءة السريعة
من أجل قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب المعدة سلفا للاستهلاك السريع، مثلها تماما مثل الأكل السريع fast food، وكما أن نمط الأكل السريع يؤدي إلى عسر عويص في الهضم، وقد تكون سببا في سمنة مفرطة أو أمراض مزمنة، فإن القراءة السريعة غالبا ما تؤدي إلى مشاكل عويصة في الفهم، وإلى إنتاج عقول فضفاضة، ممتلئة بقطع شتى من المعارف الجاهزة، و بضاعة من الأفكار الواردة من سوق صناعة الرأي. والحال أن القراءة لا يمكن إلا أن تتناسب ومحتوى المادة المقروءة، وكما أن ثمة أكلا لا يستهلك سرعة، فثمة قراءة لا تستقيم إلا بالتأني، إن لم نقل بالبطء، لا بفرط السرعة، لأن حركتها مساوقة لحركة الفكر التي تنطوي عليها المادة المقروءة. لذلك يستحيل أن تقرأ بسرعة كتبا بعينها لكبار الفلاسفة والشعراء والروائيين وغيرهم، لكن تستطيع أن تستهلك بسرعة فائقة كل الكتب التي لم تتشكل في الذكاء الاصطناعي وحسب ، وإنما في سوق صناعة الرأي والكتابات السريعة التي لا ترضي سوى الرغبة في الاستهلاك. وقبل أن نساءل الذكاء الاصطناعي، يجب أن نساءل هذا النمط الزائف للقراءة الذي ينتج هذه العقول الفضفاضة التي تفهم في كل شيء، إلا في الحياة التي لا تعاش حقا إلا بفكر متبصر ومن خلال فن أصيل للعيش يعبر عن الوجود برمته.
4 ـ ليس جديرا قط أن ينتسب للفلسفة
لكي تكون فيلسوفا بحق، لا بد أن تكون مقتدرا على صياغة الجملة الفلسفية، كشرط أدنى، بغض النظر عن صوغ المفهوم بالجملة الفلسفية. والحال أن من لا يتحدث لغة الفلسفة في حدها الضروري على الأقل، فليس جديرا قط بأن ينتسب للفلسفة، حتى ولو كان مشتغلا بها كأجير فقط من أجل مجرد العيش، وليس كمشتغل عليها كخديم مخلص وعاشق لتجربة التفلسف، كفن للعيش في أفق الحياة.
إن الفلسفة ياصاحبي لا تتم كتميمة تنكشف بها صالحات الأعمال المقدرة كما هو الشأن بالنسبة لعقيدة التسخير، أي كلاحق من اللواحق الطارئة على حديث النعمة، ولكنها تنكشف كجهد واقتدار على ابتكار الكائن لنمط الوجود في العالم، أو كانكشاف لمفهوم جدير بكينونة تمفهم الوجود.
5 ـ التفاهة تلبي الرغبة الضرورية في شيء من الابتذال
ثمة تفاهات نحيا بها، وثمة تفاهات قاتلة؛ أما التفاهات التي نحيا بها، فهي ليست سوى تزجية عابرة لوقت نقضيه من غير فوائد مباشرة، من قبيل ما يطفح به نمط حياتنا اليومي من نكات سخيفة، أو من كلام مكرور جار على منوال العادة أو الحياة الناسية، او من مشاهدة أفلام هابطة لا تتوفر على أبسط قوام فني أو جمالي، أو سكيتشات رديئة على الرغم من وعينا بأنها كذلك، أو حتى بتتبعنا في بعض الأوقات اليسيرة لفيديوهات ما يسمى الآن، بمقتضى معيار التفاهة عينها، الروتين اليومي كما هو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، أو غير ذلك مما تحفل به الحياة اليومية من مواقف هزلية يتم ترويجها في العالم الرقمي، كأسلوب إما للتندر من الحياة، أو لتكسير العادات. وهذه التفاهات، بالرغم من كونها خالية من الفائدة بكيفية مباشرة، إلا أنها لا تخلو من فائدة غير مباشرة، لهذا فهي تتضمن الحد الأدنى من التفاهة التي لا يمكن للإنسان تجنبها، كونها تلبي تلك الرغبة الضرورية في شيء من الابتذال، من أجل بلوغ أقصى درجة من الكمال، كونها مجرد ترفيه عن الذات، أو كوسيلة للتعبير عن راحة روحية لا غير، لاستئناف الجهد المبذول من أجل كمال أعظم للروح، خاصة إذا لم تتعد الحد الأدنى لتزجية الوقت، أما إذا تعدت ذلك وتحولت إلى إدمان، عندها تصبح تفريطا في الحياة.
وبالمقابل ثمة تفاهات قاتلة، لا تقدم نفسها على أنها تفاهات، وإنما كمواقف جدية، محشوة بإيديولوجيات تعادي الحياة، كونها لا ترى الحياة في بعدها المزدوج، أي كحياة من أجل الكد من جهة، وكحياة من أجل الفن، بل لا تراها سوى كحياة تافهة عديمة الجدوى، وأن قيمتها ليست كامنة فيها، بل في اكتساب تلك القناعات التي تتنافى والطبيعة البشرية، بل تتنافى مع الحياة برمتها، وهو ما قد يبلغ بهذا النوع من التفاهات حد تعديم كل غير يرغب في الحياة، بل في تعديم الرغبة كلها في الحياة.
6 ـ الوسيلة تنطوي على الغاية
في كل الأحوال، تبرر الغاية الوسيلة، وليس العكس صحيحا، إذ أن الوسيلة لا تبرر الغاية، وليس بإمكانها ذلك، كونها مجرد وسيلة في كل الأحوال من أجل غاية ما. لهذا هناك ثمة تأويلان لهذه القضية.
التأويل الأول هو التأويل العادي أو الأداتي الذي يعني أن الوسيلة تنطوي على الغاية، أي أن بلوغ الغاية يبرر استعمال كافة الوسائل من أجل تحقيق الغاية، ولو باستعمال كل الأساليب غير المشروعة من أجل غاية ما، بوصفها غاية من أجل الهيمنة كاستحواد على الكون اوإخضاع للغير أو من أجل غاية خاصة أو فردية تظهر ذاتها كمنفعة خاصة مرتبطة بأسلوب فرد في تحقيق مبتغاه، وقد تظهر ذاتها كمنفعة عامة زائفة، ينوب فيها شخص ما عن شعب برمته، كما هو حال الطاغية الذي يجعل من نفسه راعيا للمصلحة العامة، مستعملا كافة الوسائل من أجل الهيمنة على مصير شعب بعينه، كما يستعمل في الآن ذاته نفود طغيانه من أجل الاستقواء على شعوب أخرى، فلا يتورع في اللجوء إلى العدوان على مصائر شعوب أخرى، كما هو حال كل طغاة العالم منذ بداية التاريخ وإلى الآن. وفي هذا التأويل تتخذ الإيديولوجيا شكل التبرير الممنهج لكل الأساليب الممكنة التي يتم توظيفها من أجل تمجيد الغاية الغائية أو الأخيرة.
أما التأويل الثاني فهو التأويل الميتافيزيقي الذي يعني أن الغاية تنطوي على الوسيلة، أي أن بلوغ الغاية لا يتم عبر كل الوسائل الممكنة، وإنما عبر الوسائل التي لا تتنافى وقيمة الإنسان، بوصفه غاية أخيرة، وليس مجرد وسيلة. ولهذا فالغاية قد تبرر الوسيلة التي لا يكون فيها الإنسان هو الوسيلة ذاتها، وإنما تكون فيها الوسائل المشروعة تقود إلى غاية أخيرة هي الإنسانية، كالعدالة والإنصاف، والديمقراطية وكل الأساليب التي تجعل من فن العيش تقديسا للحياة برمتها. بهذا المعنى الميتافيزيقي تكون الغاية تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية هي حرية وكرامة الإنسان وصون العيش المشترك أو بالأحرى بلوغ أعظم الكمالات، فإنها لا تبرر سوى الوسيلة الأشد انسجاما مع هذا المبدأ كالديمقراطية على سبيل المثال كوسيلة ليس إلا. أما إذا كانت الغاية غير ذلك فإنها تبرر كل الفظاعات الممكنة، وبكافة الوسائل، بما فيها الاستغلال الأفدح للعقائد من أجل العدم.
7 ـ ما الذي يمكنني أن أعرفه؟
يعبر العقل الاصطناعي عن العالم برمته، كانكشاف أخير للإنسانية جمعاء. وهذه مسألة حتمية تفوق كل إمكانيات البشر، لأنها لا تعبر عن مجرد رغبات بشرية فردية، بقدر ما تعبر عن تلك الرغبة الفائقة التي يختزل فيها الوجود الإنساني كله داخل ما يمكن تسميته بالأنطولوجيا الرقمية، التي مست في الصميم كل رغبة انثربولوجية خاصة، وحولتها إلى مجرد رغبة رقمية، وهي بذلك لا تحول دون إمكانية المعرفة بالنسبة للإنسان، أو ما الذي يمكنني أن أعرفه؟ كسؤال كانطي محض، وإنما تجعل من ذاتها إمكانية فائقة للمعرفة التي تتجاوز قدرات العقل البشري على إنتاج المعرفة. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن قدرة العقل البشري ليست ممكنة الآن في هذا العالم الرقمي بدون وساطة للعقل الاصطناعي. بل إن ماهية الإنسان عينها صارت بدورها رقمية. ولهذا ينكشف السؤال مجددا: من هو الإنسان؟ هل هو هذا الكائن الإنساني الذي يعبر عن العالم، كما لو كان راعيا للوجود؟ أم هو هذا الكائن الإنساني الذي ينكشف بدوره في عالم الذكاء الاصطناعي ككائن رقمي. إذن من هو الإنسان؟ هل هو كائن انتهى زمانه؟ وإذا انتهى زمانه الذي تؤسسه رغبته الأنثربولوجية، فما الذي يكونه هنا والآن فيما يمكن تسميته ما بعد الإنسانية؟ وهل ما بعد الإنسانية ليس إلا مجرد استعارة تحكي الانكشاف الأخير للتاريخ كعقل كوني لرغبة ترهن الاقتدار البشري في عقل كلي يتحكم في التاريخ، ربما على نحو هيجلي، حيث ينكشف العالم ككتاب لامتناه الحدود وكأفق مفتوح؟
8 ـ أنطوي بدوري على هذا الزمن
لو خيرت أن أعيش في زمان آخر، مع أن “لو” هذه ليست من قبيل الفرضية الممكنة قط، ولا يمكن أن تكون كذلك، لاخترت أن أعيش في زمن ذهبي يكون بالنسبة لي، بمثابة كمال أعظم لكينونتي. والحال أن الزمن الذي يمتاز بهذه الخاصية، لا يمكن أن يكون زمانا آخر لم يقدر لي أن أعيش فيه، ولكنه سيكون بضرورة الأنطولوجيا هو زمني المقدر لي للعيش فيه، أي أنه لن يكون سوى هذا الزمن الذي ينطوي علي في كينونتي العابرة انطواءه على سائر الكينونات التي أجاورها وتجاورني داخل علاقة تعاصر ليست تقوم إلا بكيفية محايثة وعلى سطح المحايثة ، كما أنني أنطوي بدوري على هذا الزمن الذي يتعين في ذاتي كشكل للعالم الذي أعيشه كحاضر، أي كتجل لتعال ينكشف فيه الوجود في ذاتي كنمط لهذا الحاضر، أي كنمط لكينونتي الخاصة. لهذا لا أسف على زمان نراه كأفق افتراضي لعلاقة مستحيلة، وإنما نأسف على حاضر متاح لنا لكننا ضيعناه حسرة، وتعلقا بزمان ما، كزمان ذهبي، ليس ناتجا سوى عن العلاقة المختلة بالحاضر، والتي لا تنتج سوى عن إيديولوجيا معاكسة للحياة، كتجربة لا تقوم إلا في الحاضر كمعطى متاح للكينونة دوما وأبدا، وكأعدل قسمة بين الكائنات.
9 ـ الإنسان يأنس بالحياة الناسية
في كل الأزمنة ثمة سبات دوغمائي يلازم الحياة البشرية، حتى ولو انكشفت كل الحجب. إذ أن الحياة التي ينهكها الجهد المبذول في اليقظة من أجل الوجود، يتسلل إليها العجز كشعور زائف، أو كلاوعي يعبر عن نفسه من خلال السأم أو الملل الذي قد تترتب عنه كآبة الكائن، ما لم يستشعر هذا الكائن في ذاته درجة الوعي باليقظة الخلاقة التي يمكن أن يستعيد من خلالها جدوى الحياة. ولأن الإنسان بعامة كائن ناسي، فإنه يأنس بالحياة الناسية، أي الحياة التي يفتقر فيها إلى الوعي بالاقتدار على الوجود. لهذا يستسلم الإنسان للعدم، ليس رغبة فيه، وإنما رغبة في الوجود من غير جود، أو من غير بذل أي مجهود، وذلكم هو السبات الدوغمائي الذي يغذي الرغبة في خلود زائف، لا يستند للقدرة كفعل خلاق، وإنما يستند للعدم ككيفية للتملص من الحياة.
10 ـ يوجد لأنه يوجد
الوجود هو الكمال عينه، بما هو مطلق الكمال بالضرورة، كونه يوجد لأنه يوجد وحسب، ولأنه منطو على كمال وجوده. غير أن الكمال الذي يوجد فيه، لا يعبر عن كماله من خلال الوجود ذاته، بل من خلال الموجود الذي ينطوي عليه. لذلك كان الكمال لا حقا على الوجود، حتى ولو أنه من صلب ماهيته، ما دام أن الموجود يتخذ من الكمال غايته الأخيرة في الوجود.