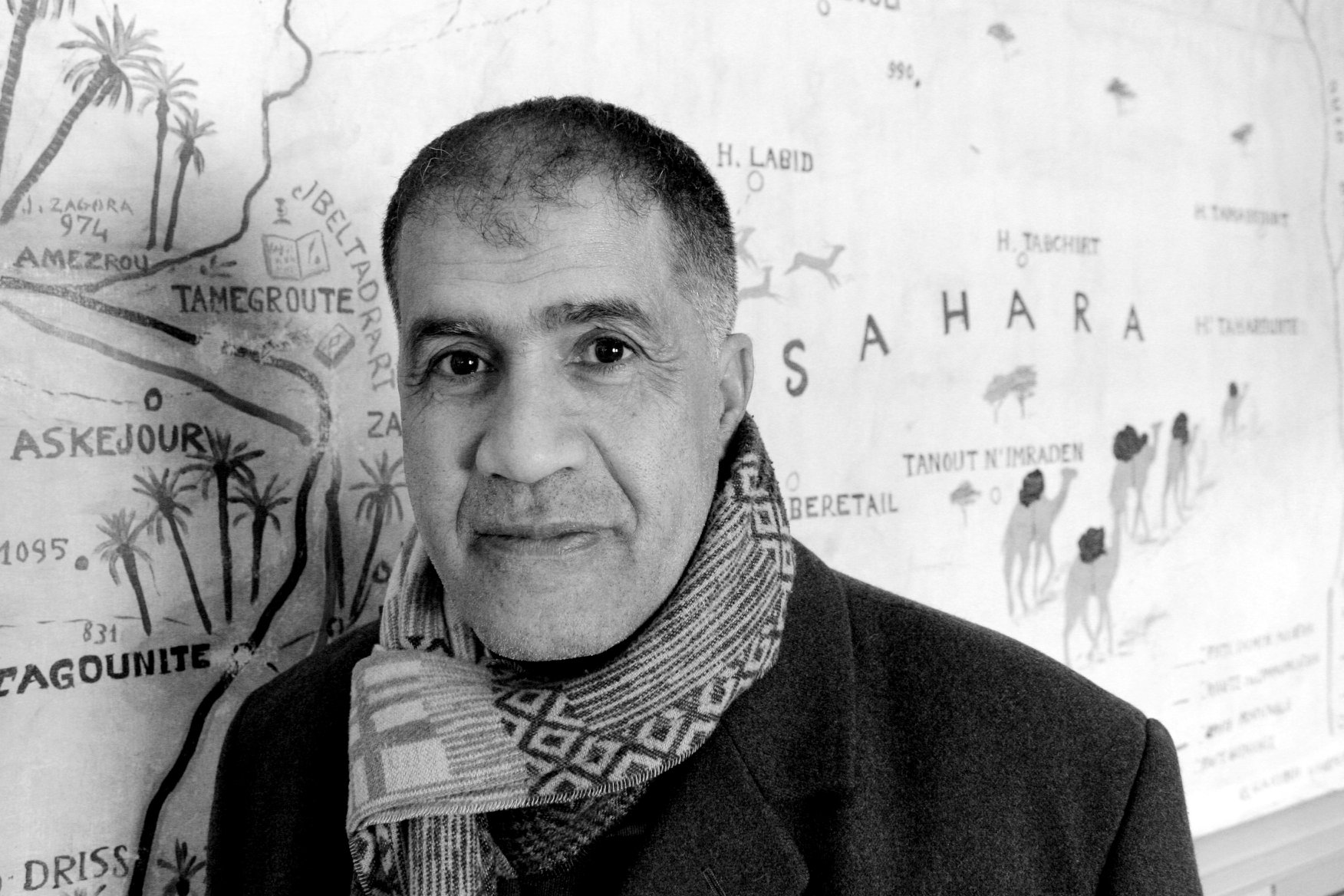
أحلم كما يحلم غيري، في هذه الصحراء المترامية الأطراف، بالسكن في الدارالبيضاء، أو زيارتها على الأقل.. كنتُ سعيدا جدا، بالعثور على عمل مع مقاول في البناء من بلدتي تاكونيت، لم أنم تلك الليلة، مِمّا اضطرني إلى الخروج بعيدا عن قصر بني هنيت.. سرحتُ في الخلاء، أتفسح ليلتها تحت ضوء الكَمرة الساطع..ولأول مرّة شاهدتُ جرائد النخيل تلمع برّاقةً تحت أضوائها.. والطيور تطير من نخلة لأخرى، هل هي كذلك يؤرقها فرح الهجرة إلى حقول أخرى، أكثر غذاءً من حقول تاكونيت الجذباء ؟ ولم يراودها النوم مثلي؟ من يدري؟ .. وهذا البحر الذي طالما سمعتُ عنه، وتشوقتُ إلى رؤيته. قلت لأتأكد بنفسي، من هو أكبر حجما، البحر أم، وادي درعة؟ وهل سكان الدارالبيضاء، يهتموا هم كذلك – بتلقيح_- ذُّكار النخيل مثلنا؟
في الحقيقة، أنا أحلم بهذا السفر، كما كان أبي يحلم بالذهاب إلى الحج، أو العمرة،، هو الذي تخيل أشياء كثيرة جميلة هناك، ولم يجدها في حجه.. قال لي عند عودته الميمونة من الديار المقدسة: إن ما تخيلته عن الحج، والعمرة، كان هو الحج بذاته وصفاته.. أما ماشاهدته هناك، فقد خيب ظني ورجائي.!

أعرفُ بثقافة السمع فقط، بأن الدار البيضاء، نهضتْ على سواعد رجال الجنوب،كما أعرف، ويعرف غيري ممن هاجروا إليها باكرا، جاؤوا إليها حفاة عراة، فأصبحوا يرفلون في رغد العيش ، ويتنعمون بالجميلات، والسيارات الفاخرة، و..و.. ربما كان ذلك في زمان آخر، قبل أن تمتد إلى ترابها معاول التقسيم السياسي، والأمني، مع بداية الثمانينات، وشهداء كوميرة.
أما أنا، فلقد رأيت بأم عيني هاتين يأكلهما الدود، إن هما جانبتا جادة الصواب.. صور أبناء بلدتي عند عودتهم، من الدار البيضاء، محملين بالغنائم والملامبس، والأثاث، والأدوات الفلاحية، إلى بلدتنا تاكونيت، كانت تلك الصور، تذكرهم عند حلول كل مناسبة من أعياد الأضحى، هو ما حفزني الآن، إلى السفر إليها.. تخطيت جدولا صغيرا من ماء السد الشحيح.. حتى وجدت نفسي تيّاهاً في- الكاطع- الضفة الأخرى من الوادي، بعيدا عن الدوار.. حين سمعت صوت أبي يهلل، قبل آذان الفجر، خففت من خطاي حتى أقوم بجمع حاجياتي استعدادا للهجرة..كنا أربعة أشخاص داخل سيارة رونو4R سمعتهم يقولون بأننا تجاوزنا مدينة بن كرير ، كانت رموش جفوني مثقلة بالنوم، ولم أر شيئا في الطريق.. أكتفيتُ بالسماع لشروحات رفقاء السفر، حين أحببت أن أطل على معالم الطريق، كانت السيارة شبه حاوية حقيقية من الحديد، ولاأعرف لماذا لم أفطن، بأنني في زنزانة متنقلة ، نعم، زنزانة بأربع عجلات، تحمل سجناء الأحلام، أرادوا نقلهم، من سجن إلى آخر، يقع في مدينة أخرى، نأية عن بلدتهم، حتى لاينشرون عدوى أحلامهم، المفزعة، بين الأهالي والجيران، و إلا كيف لي أن أسافر في صندوق من حديد، الرؤية فيه منعدمة؟ تبقى الرؤية الوحيدة فيه، إما من الزجاج الأمامي، وإما من الخلفي فقط.. وصلنا عشية السبت، مع آذان المغرب ، ثم ترجلنا من سيارة ..
( الإير كاط )
دخلنا إلى حوش مسوّر بالآجور من حجم 40 سنتيمترا، دلفنا من بابه الخشبي، الملطخ كله بالإسمنت، وجدنا أسّرة مصنوعة من الطوب الأحمر، فوقها ألواح خشبية خشينة و غليظة. دون وعيّ مني، بدأت أتحسس ضلوعي، حين تمددت على طولي فوق واحد من تلك الأسرة، انبثق إليّ شبح أبي في سقف الكوخ، وهو يردد عليّ خيباته التي تخيلها : .. ما تخيلته عن الحج في وجداني و خيالي أفضل بكثير مِمّا شاهدته في الواقع!

نهرني الشّاف،بصوته الخشن، حتى أفزعني و وأخرجني من شرودي : مازلت لم تخدم يوما أو يومين، حتى غرقت في بحر التخمام ؟ ياكما توحشت مدام..؟
كان العربي الصبيحي يصغي إلينا، ويشفط الكيف من سبسيه بصوت مسموع، فت آفت، حين انتهى من فعله ذاك، ردّ علينا بكلامه، المملوء بالأسى والحسرة : واااخُلطَا هاذي.
تفضل علينا الشّاف أمبارك، بيوم راحة، قبل شروعنا في أوراش العمل.
اقترح علينا بوجمعة الكنزيطي الذهاب إلى البحر. وعليه، فضلنا العربي الصبيحي، بأن يكون هو دليلنا السياحي، نظرا لأقدميته في الدار البيضاء.. ركبنا الترامواي ، من حي أناسي إلى عين الذئاب.. صاح في وجهي المزغوب بّا عروب، وزمم ما شفاته عينيك، وما قريت من سّمِيات الشوارع، آخويا الحسين.. كان الكافر بالله، يعنيني، أنا بالذات.
في البحر ظللت منبطحاً على بطني، ولم استطيع القيام والوقوف على رجلي.. حتى لايكشف أمري.. رأيتُ ما لم يراه أبي في حجه وخياله، وكنت أناديه في دواخلي،، تعالَ يا أبتاه، معنا، ترى وتسمع، ما لم تراه أو تشاهده في حجك !
كنتُ غِرّاً و بليداً، حين كان المسكين، يزبد ويرغي، ويغضب علي بدعائه الغليظ: سير الله إيديك البحر.. كنت حينها أبكي من دعائه وسخطه علي.. أما الآن، فأردُّ عليه، اللهم آمين.
ها أنا،أناجيك يا أعز الأباء ، أن تعال وأفك أسر وثاق ابنك حتى يتخلص مِمّا شلّه، ويستطيع الوقوف على قدميه ، وألايبقى منبطحا على بطنه فوق رمال مبللة هكذا،،
الصبيحي اللعين، يراهنني بعشاء إن أنا استطعت الوقوف والاتيان إلى عنده.
كنتُ أحاول ، ولم أستطيع، بل أردتُ أن أواري سوأتي حِجري، ولم أفلح، لأن آلام مغص الكلي مزق بطني تمزيقا حادّاً كشفرة الحلاقة!

قفلنا عائدين من البحر- الذي هو فعلا، بحر، بفقماته الآدمية – ذاك المساء، إلى معتقل الأسِّرة العقابي. سألت العربي الصبيحي، (الكَناز)، عن اسم المكان الذي نتواجد فيه الآن؟
ردّ عليّ ساخرا : (كنتَ البارحة في سُرّة الدارالبيضاء، أما الآن ،فأنتَ محشوراً في…)
سكنا ستة أشهر في دوار فران الحلوة، الذي لم نكن نبرحه إلا لقضاء حاجتنا قرب حائط الأطوروت، أو أيام الآحاد،للذهاب إلى حمام الموتشو.
كنتُ أشاهد الدار البيضاء، من فوق تلة عالية.. ولاأرى منها، إلا صومعة المسجد الكبير، وبعض العمارات العالية،كم كنتُ أتباهى في مراسلتي عن أهل الدوار، والقبيلة، بكتابة الدار البيضاء، بخط عريض، فوق ظهر مظروف الرسائل .. وكان الصبيحي اللعين يطنز عليّ، آآباه..آآباه..آآآباه، الدارالبيضاء ؟ ويضيف بمرارة، آمصاب غ لي طلل عليك من أصحاب لبلاد وشافك فين كاين ؟
في ليلة عيد الأضحى، حشرنا الشّاف أمبارك، مع أمتعتنا في سيارته الإير كاط.
في طريق عودتنا، إلى الصحراء، اعترض طريقنا حاجز ثلجي عند قمة جبل تيزليدة..ولم نصل بلدة تاكونيت، إلا في اليوم الموالي، لعيد الأضحى.
قال أبي، فرحا بعودتي: لقد نحرنا البارحة جدي صغير، واحتفظنا بذبيحة العيد، إلى حين مجيئك من الدار البيضاء.
أجبته مستغربا: وهل أنا جئتُ من الحج، يا أبتاه، حتى تكلف نفسك، بهذا الذبح العظيم ؟

رفع ذراعه عاليا، وردّ عليّ بكلامه الساخط:
الدارالبيضاء، آلمزغوب، هي الحج.. الدار البيضاء هي كل شيء.. هل سمعت ما غناه حماد الروحي ، في مدحه لها: (الدار البيضاء عاليا ..
فيها خوخة وداليا
فيها بزبوز النحاس
يكب الما بلاقياس
فيها سيدي بليوط ما يفرط فيا)
غمغمت بيني وبين نفسي.. ولم أعقب عنه.
كان ألم الكلي الفظيع قد عاودني، حتى أخرسني عن الكلام.
(صورة الكاتب : أحمد بنسماعيل)








