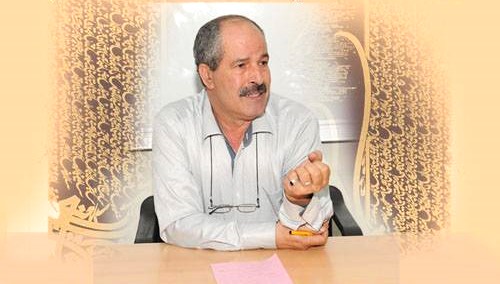
ما كنت لأفكر في هذه المقالة لولا ما عاينته من بعض الردود على مقالاتي، سواء في «القدس العربي» أو على صفحتي في فيسبوك، أو على ما أتابعه من سجالات مَرَضية في الوسائط الجديدة. أشكر كل المتابعين، سواء اتفقت معهم أو اختلفت. ولا بد من الاختلاف لأنه أساس الوجود الإنساني، لكن الاختلاف حين لا يتوفر على مقومات الحوار والجدال بالتي هي أحسن يتحول إلى حرب «باردة» أو «ساخنة» حسب لهجات ولغات المتناقشين، ويظل كل طرف متمسكا بما لديه، معتبرا إياه الحقيقة التي لا تعلو عليها كلمة.
تتعدد المقالات التي أكتب، حسب تعدد النوافذ والموضوعات التي أفتح للتفكير والسؤال، لكن بعض المتدخلين لا يحلو لهم التعليق إلا حين أتناول الإسلام، أو أذكر كلمة العربي والعربية، فتكون كتاباتهم مخالفة لما هو متعارف عليه من أخلاق الحوار. إني أنطلق في ردودي على ما يكتب عن الإسلام من المسألة المتعلقة بما أسميته بالهوية الثقافية التاريخية، ومن لا يؤمن بها في نطاق ما هو جار عالميا له الحق في ذلك، لكنه في إطار الحوار غير قادر على تحديد نقيضها محليا وجهويا وعالميا، وعندما أرى في تواتر الحديث عن الإسلام والعروبة من لدن فرنسيين وعرب يسيرون على نهجهم، لا يمكنني إلا أن أستنتج أن هناك مخططا، ومن يدعي عدم وجوده ما عليه سوى معاينة موقف فرنسا من المغرب بجلاء، من الزلزال، ومن الحجاب، وما يقدمه الإعلام بخصوص المغرب.
لقد ابتذلت كلمة «المؤامرة» ويتم توظيفها ضدا على الوقائع الدالة عليها بوضوح. لا إعلام بريء، وهو يستغل أي مناسبة للنيل من طموح مغرب اليوم، الذي لا يريد أن يظل كما كان في الماضي، ويمكن قول الشيء نفسه عن فرنسا وموقفها من افريقيا. يقول البعض إن نقد الخطاب الديني ضروري. لا أشك في ذلك، بل أدعو إليه، لكنني ضد التزييف والتجهيل.
لقد بينت في مقالتين جهل أحدهم باللغة العربية، وتأوله مسألة المخنث، وموقف الرسول (ص) من الغناء، في الوقت الذي استنكره أبو بكر. وتابعت بعد ذلك عدة فيديوهات له ولأمثاله فوجدتها تسير في الاتجاه نفسه: ضحالة فكرية، ومتخيل مريض، فهل في هذا النقد الموجه إلى مثل هؤلاء، وقد تناسلوا، واستنسخ بعضهم بعضا، موقف من نقد الخطاب الديني؟ أتمنى أن أجد من يمارس نقدا جديدا وموضوعيا ومقنعا للخطاب الديني بكيفية حضارية وذات آفاق لتوسيع النقاش والحوار حول الدين عموما والإسلام خصوصا.
إننا بهذا نتجاوز التفاهة التي هيمنت مع الوسائط الجديدة، ومارسها كل من يعمل على استغلال موضوع يهم الجميع للإثارة وتحصيل الرزق. ماذا يمكن أن نقول لمن يدعي أن الرسول غير موجود، أو أن هناك محمدا آخر، وما شابه هذا؟ هل علينا أن نثمن نقده الخطاب الديني، ونشجعه للثورة الكوبيرنيكية، التي تجعله يغير كل تاريخ الفكر البشري منذ ظهور الإسلام؟
لا غرو في أن هناك من يقلد ما أنجز في التراث الإسلامي، ولا يضيف إليه شيئا، بل إن بعضهم من يفتي وليس أهلا لذلك، لكن أن نتخذ مثل هؤلاء ذريعة للنيل من التاريخ الإسلامي، ومن شخصيات إسلامية ترجمت أعمالها الجليلة إلى أكثر لغات العالم، وتقام حولها دراسات علمية مختلفة في الغرب نفسه، فليس في هذا سوى التطاول والتعبير عن الجهل. لا أفرق بين هؤلاء الشيوخ الذين لم يتطوروا، ومن يدعي أنه من أنصار الحداثة والتنوير. إن هذه الفئة الأخيرة لا تجد في جعبتها ما تناقش به الإسلام، سوى ما قاله المتعصبون من الغربيين فقط لأنه يتماشى مع معتقداتهم. فما هو الفرق بين من يتحدث عن التحديث، والديمقراطية، ومن يسميهم السلفيين أو مقدسي السلف في العمق؟
لم ينجح التقليديون في تجديد الخطاب الديني، فهل نجح التحديثيون عندنا في تجديد فكر الأنوار، وعملوا على النظر في التطورات اللاحقة لعصر الأنوار إلى الآن، وما عرفه في صيرورته من تحولات فكرية وإبستيمولوجية واجتماعية؟ فما الفرق بين من يدعي أن هؤلاء سلفيين يقدسون البخاري ومسلم، وسواهم من شخصيات تاريخية. ألا تراهم أيضا سلفيين يقدسون هيدغر، وسبينوزا، ونيتشه. فمن منهم يدعي تجديد الفكر الغربي؟ يبدو لي أنه لا فرق في واقعنا المغربي والعربي بين الداعي إلى الأصالة أو الحداثة. تجمع بينهم ذهنية الاتكال على الآخر، وعدم بذل المجهود في العمل، وفي امتلاك أدوات البحث العلمي. إنهم يكتفون بما جمعوه من شعارات أو أفكار عامة، وبها يتصارعون ويجترون خطابات لا يتجاوزونها أبدا.
إننا لا نؤمن بالسؤال، ولا نعمل من أجل الجواب عنه بالحكمة والبحث العلمي المضني. ما أسهل أن نمارس دور «البراح» في المجتمع التقليدي، وندعي أننا «ناشطون» ثقافيون، أو «مؤثرون». الناشط الثقافي هو ابن الميدان، وليس منتج خطابات ترويجية لأفكار غير ناضجة، ولا مؤسسة إلا على «أطروحة» جاهزة.
نقد أي خطاب ضرورة، وتجديد الفكر مطلب. وممارسة الحوار الحضاري مدخل للتطوير والتجاوز.








