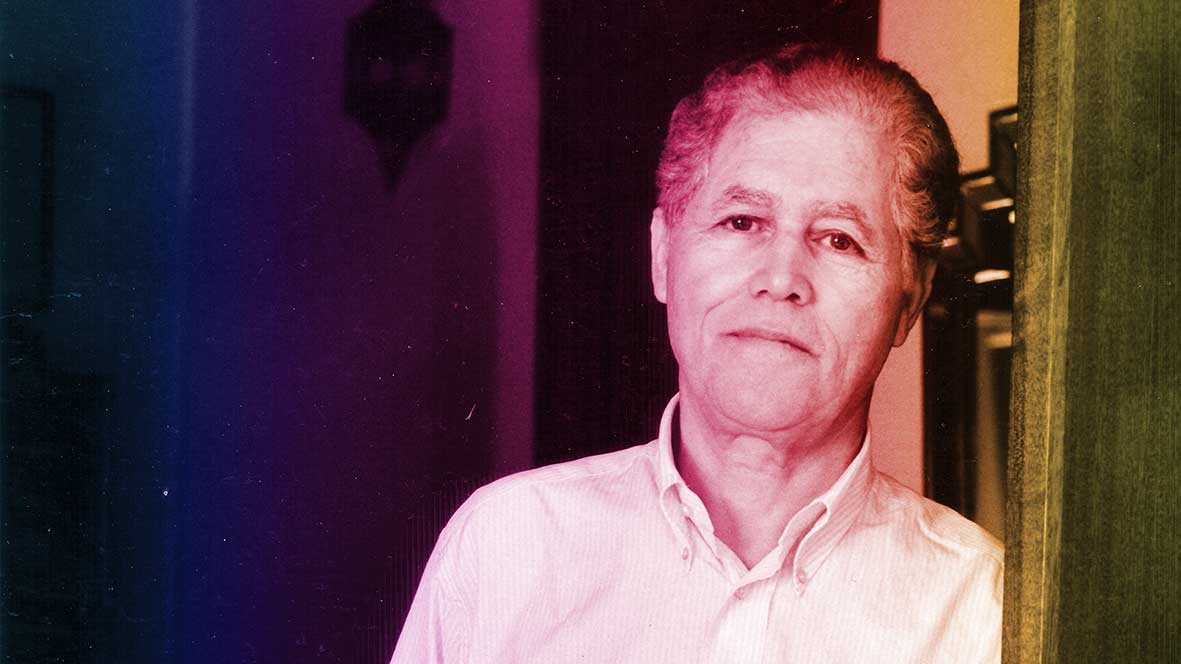
من الجلي أن أطروحات عبد الله العروي حول تأثير الفتح الإسلامي في مختلف الشعوب التي شملها لا تتفق مع الحقائق المعروفة، وبأنه لا يتردد في السفر بارتياح كبير بين مجالات وحقول متباعدة، غير مكترث بما تحمله من خصوصيات تميزها فيما بينها على نحو لا مكابرة فيه. حسبنا هنا أن نلاحظ أن الأطروحة التي يسوقها في مؤلفه “مفهوم العقل” بخصوص تماهي الحكاية (“ألف ليلة وليلة”) مع الحضارة الإسلامية وذوبانها فيها إلى حد أنها تشكل قطيعة جذرية مع كل المنظومات الثقافية ما قبل الإسلامية، ما هي في الختام سوى إعادة إنتاج لتلك التي دأب الدفاع عنها في مجال التاريخ.
نراه يقول: “لنفرض أن مؤرخًا إسلاميًا لا يتوفر إلا على [كتاب] الأخبار الطوال للدينوري، ولنفرض أنه لاحظ تشابهًا بين هيكل الكتاب وملحمة فارسية قديمة، فراح يؤول كتاب الدينوري، لا بالرجوع إلى منطق الأحداث، ولكن إلى منطق النمط الموروث الدال على استمرار الذهنية الآرية حتى بعد اعتناق الإسلام واستيعاب اللغة العربية. هل تبقى له وسيلة لمعرفة ما وقع بالفعل في فارس بعد الفتح؟ هل يبقى أي مجال لبحث تاريخي بالمعنى المعروف؟” (“مفهوم التاريخ”).
أول ما يسترعي انتباه القارئ لهذا النص هو لجوء الكاتب إلى مفردات فضفاضة تتطلب المزيد من التمحيص والتحليل. فعبارة “منطق الأحداث”، التي يلجأ إليها كمسلمة لا تقبل النقاش، من شأنها أن ترغم القارئ ذاته على طرح سؤال بديهي، وهو: من ذا الذي يجرؤ على الادعاء بأنه بوسعه ملامسة واقع أحداث مرت عليها عدة قرون، ولم يعد بالإمكان الاطلاع عليها إلا من خلال نصوص تم تناقلها ردحًا من الزمن بوسائل شفوية محضة، طالها التحريف والتشويه، واختلط فيها التاريخي بالأسطوري، ناهيك عن تشعبها وتفرعها إلى عدة روايات؟
وبناءً عليه، فالرواية التاريخية تستلزم القراءة عن كثب لتحديد مدى صحتها، أي مطابقتها للأحداث التي ترويها، دون إغفال بعد آخر في غاية الخطورة، وهو أنها كذلك وفي الآن عينه حكاية، أي عمل سردي يخضع، ردحًا من الزمن، إلى آليات التداول الشفوي، ومن ثمة يصبح عرضة للتغير والتحول والتشوه، وينمو ويغتني عن طريق الاقتراض والتناص. وقد يُقرأ في مرحلة معينة على أنه تسجيل لوقائع لا غبار على بعدها التاريخي، ليصبح فيما بعد “مجرد” أسطورة. خلاصة القول، فالأبعاد التاريخية التي تشكل، مبدئيًا، النواة الصلبة للرواية التاريخية، ليس من الضروري أن تكون دائمًا موجودة، فالرواية قد تكون منذ نشأتها مجرد “ملحمة” أو “أسطورة”.
ولا أدل على الأهمية القصوى لهذه النقطة أن العروي نفسه يثيرها باستمرار، مؤكدًا أن “الخبر المسموع يسبق في التاريخ الخبر المكتوب”. وهو لا يحجم عن استنتاج الخلاصات التي تفرض نفسها في هذا الشأن، إلا لأنه يعي تمامًا بأنه سيكون عليه، في حالة الأخذ بها، إعادة صياغة أطروحاته حول الرواية التاريخية من جديد. كما أن مفردتي “اعتناق” و*”استيعاب”* تنمان عن تصور آلي، يفترض أن الشعوب تفتح دائمًا ذراعيها للجديد من المعتقدات وأساليب التفكير، حتى عندما تمر عبر السيف، ولا تتردد في اعتناقها واستيعابها عن طيب خاطر ودونما أدنى مقاومة.
ألا يحق لنا البناء على ما يقوله العروي في سياق آخر بخصوص مقاومة الرومان للمسيحية خلال أربعة قرون، “وبأدلة تحتفظ بوجاهتها إلى يومنا هذا” (“استبانة”)، وكيف “تطلب إسلام البربر وتعريبهم زمنًا طويلًا” (“مجمل تاريخ المغرب”), لطرح افتراض مفاده أن الفرس، النموذج الذي يرتكز إليه بإحالته إلى الدينوري، قاوموا، أسوة بالرومان قبلهم والبربر بعدهم، الديانة الجديدة؟ خاصة وأننا لا نتحدث عن السكان الأصليين لأمريكا، الهنود الحمر، النموذج الذي يقدمه العروي كتجسيد للشعوب التي تتلاشى لاعتقادها بأن “الانحطاط سُنة لا تقاوم” (“استبانة”), ولكن عن بلاد فارس، الحاملة لإحدى أعرق الثقافات وأقوى الحضارات عصر ذاك. ولا أدل على ذلك من أنها تمكنت، على عكس ما يلاحظ في شمال إفريقيا، على سبيل المثال، من الاحتفاظ بلغتها الأصلية.
فضلًا عن ذلك، فهذه الأخيرة تركت بصمات واضحة في لغة الفاتحين وثقافتهم، بما فيها الموسيقى، التي لا تزال إلى الآن تحتفظ بالأسماء الفارسية لمعظم مقاماتها، انطلاقًا من سُلمها الأساسي، وأساليبهم في التأليف والكتابة، بل وحتى في القرآن، مرجعهم الديني الأساسي. ناهيك عن أن العناصر ذات الأصول الفارسية كان لها شأن كبير في إدارة دواليب الحكم وتعزيزها، والدولة الإسلامية في أوج عنفوانها. وإذا كان العنصر الذي عقد ترسخ المسيحية في أرض الحضارة الرومانية هو كونها من أصول “شرقية”، فما بالك بالإسلام واللغة العربية عندما حلا عند الفرس، بعقليتهم ولغتهم الهندية-الأوروبية التي لا تمت بأية صلة لمنطق اللغات السامية؟
لنسر على خطى “المؤرخ الإسلامي” الذي يتحدث عنه العروي، والذي يجد نفسه مرغمًا على الاكتفاء بكتاب الدينوري “الأخبار الطوال”. وسنتمكن حينها من معاينة ضبابية وزئبقية مفردة “هيكل الكتاب”, والتي إن كانت تدل على شيء، فعلى الصعوبة التي يجدها العروي في عقد مقارنة واضحة ودقيقة بين مؤلف مؤرخ، يحمل كما جرت العادة على ذلك، وكما يشي به العنوان نفسه، روايات مختلفة ومتباعدة تبدأ بـ”أولاد آدم” وتنتهي بـ”ولاية محمد المعتصم”. بحيث إنه من المستحيل أن يتوفر على “هيكل” محدد، كيفما كانت طبيعته، يمكن مقارنته بملحمة فارسية قديمة واحدة مكتفية بذاتها. الطابع الاعتباطي للمقارنة يدفعنا إلى التساؤل: هل كان العروي فعلًا على اطلاع تام بمحتويات الكتاب؟ أم أن اختياره وقع عليه فقط لأن أبا حنيفة الدينوري من أصول فارسية؟








