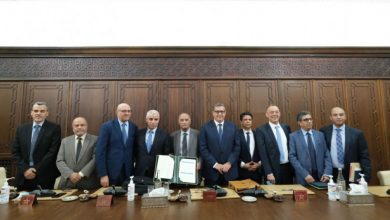كنت ما أزال أغالب، في الفراش الدافئ، إحساسي بالتراخي والخمول، عندما سمعت ارتجاج النافذة الوحيدة للمرقد بفعل انفتاح الباب، وتناهى إلي وقع أقدام، قبل أن يتعالى صوت هشام:
– وا عبد العالي؟
كرر النداء بإلحاح، وهو يخطو في الممر الفاصل بين العلبات، فأجبته منعما، متوقعا أن يدعوني إلى اصطحابه إلى أحد المطاعم، إذ كانت عقارب ساعة يدي تدنو من الثانية عشرة. كنت أشعر بالتعب يثقل جسدي، مثلما يحدث لي دائما حين يمتد سهري إلى وقت متأخر من الليل. رفع هشام ستارة العلبة، ووقف بالباب مسددا نظراته نحو السرير السفلي، من جهة اليسار، حيث كنت أتمطى. دون أن يهتم بإلقاء التحية علي، قال بنبرة تعجب:
– يبدو يا صاحبي أنك استيقظت للتو! “آش هاد النعسة”؟
انفلتت مني ضحكة، فيما أنا أحدق في وجهه الملتحي بعينيه الكبيرتين؛ كان دوما يثير ضحكي أو على الأقل ابتسامي، بعباراته الخاصة:”النعسة الحمارية”، “الدكة المعلكة”، “الكماية الخانزة”، “الهدرة الحامضة”…
أردف من غير أن يبادلني الضحك:
– الدنيا مقلوبة وأنت لست في هذا العالم!
– ماذا هناك؟
بان التردد على ملامح وجهه ممزوجا بالتوتر. لبث صامتا للحظة يرنو إلي، قبل أن يضيف:
– إحدى الطالبات انتحرت.
– حقا؟!
خفض عينيه إلى الأرض محركا رأسه بالإيجاب.
تزاحمت الأسئلة في رأسي عن هوية الطالبة، وكيفية وسبب انتحارها، ولما هممت بالإفصاح عنها مدفوعا بحجم الهم الذي بدا صاحبي ينوء تحت حمله، تقدم خطوتين نحوي، وأمسك بيدي، وقال:
– وأنت تتناول فطورك سأخبرك بواقع الأمر.
ساورني القلق، وأنا أنظر إلى وجهه المهموم وأحس في نفسي صدى نبرته المختلفة، فلم أشأ أن أستعجله لوضعي في الصورة، كأنما أخشى أن تكون لأحدنا علاقة ما بالحدث الصادم. غيرت ثيابي، وخرجت في أثره تتناوشني الهواجس. بمجرد ما خرجت من باب المرقد أعشى ضوء الشمس عيني. نزلنا الدرج، وقطعنا الطريق باتجاه المشربة. سبقني إلى طاولة شاغرة في الفسحة المحفوفة بالأشجار، والمحاذية للمشربة. وبينما اقتعدت كرسيا، انطلق باتجاه المشربة، بعد أن سألني: “شاي أم قهوة؟”. أزعجتني أشعة الشمس الساخنة، فقمت لأعدل المظلة الواسعة التي كان يرتفع عمودها من قاعدة حجرية موضوعة بجانب الطاولة. سرحت بنظراتي في ما حولي، فلم يلفت انتباهي شيء غير عادي. كان قاطنو الحي، ذكورا وإناثا، ينتشرون في فضاءات الحي المختلفة، وقد تحرروا من ضغط أيام الأسبوع، واستسلموا للإيقاع البطيء المتراخي ليوم الأحد. طلبة يفترشون العشب، يتجاذبون أطراف الحديث، أو يتناولون طعاما. طلبة آخرون يجلسون على المقاعد الخشبية الموزعة على جنبات الساحة تحت ظلال الأشجار، أو المستوية على مقربة من المراقد. طالب ينشر غسيلا على حبل. وآخرون يجلسون إلى الطاولات في الفسحة المحفوفة بالأشجار. وحركة السير لا تنقطع في مختلف الاتجاهات… وعندما وقع بصري على طالب يحادث طالبة تستند إلى جذع شجرة، على بعد خطوتين من مكاني، استبطأت هشام، شاعرا بهواجسي تتحول إلى رهاب ملموس يجثم على روحي. تخايلت صورة ثريا لناظري بوجهها المدور الأسمر، وعينيها النجلاوين العسليتين، ترتفع فوقهما رموش كثيفة فاحمة السواد، وبأنفها الأقنى وشفتيها الصغيرتين الممتلئتين، وشعرها المسترسل قصيرا إلى حدود كتفيها. تجلت لخيالي جميلة لذيذة، ورأيتها تخفض عينيها إلى أسفل، في خفر، فتعلن الرموش عن حضورها الصارخ المدغدغ لأوتار قلبي، وتنفرج شفتاها عن أسنان نضيدة خالصة البياض. وددت أن أحضنها بقوة، وأصيح: “أنت لي”. لكن صورتها اختلجت وتشوشت، حين هجست نفسي: “هي الطالبة المنتحرة دون شك”. استرجعت سلوك هشام، قبل قليل، فاستشففت خلف ندائه الملحاح وتعابير وجهه ونبرات صوته والخبر الفاجع الذي ألقاه في وجهي وتأجيله تزويدي بالتفاصيل.. استشففت وقوع الكارثة فوق رأسي. استولى علي خوف جارف على ثريا، وخشيت بقوة أن أفقدها. بدت لي أروع ما حدث في حياتي، مذ حللت قبل سنوات بهذا الحي. تلاشت لحظات الخصام والتأزم التي كانت تتخلل علاقتنا، تلاشت الشكوك التي كانت تتأجج، من فترة لأخرى، فتطوح بي في صحراء القلق والخيبة حتى أتاخم حدود اليأس، تلاشت مخاوفي من مستقبل غامض يجهض كل محاولة لعقد قراننا. بقي ساطعا ومتوهجا، فقط، وجهها بين يدي أحدق فيه بوله، غارقا في قسماته التي يخترقني حضورها العذب، جسدا وروحا. تحايلت نفسي على ما استشففته من سلوك هشام، وأقنعتني أن الأمر لا يعدو أن يكون تعاطفا إنسانيا ليس غريبا على هشام المثالي، أليس هو من يبكي تأثرا بمجرد قراءة عبرات المنفلوطي؟ أليس هو من يتفاعل بزخم عاطفي مع كل المعذبين على وجه الأرض، بدءا بمتشرد مات متجمدا من البرد فوق قطعة كارتون افترشها فوق رصيف فخم بجانب بناية بنك، مرورا بضحايا فيضان نهر غادر أو حادثة سير مروعة لناقلة ركاب، وصولا إلى المتساقطين في فلسطين تحت نيران احتلال مغتصب؟ وماذا لو كانت الطالبة المنتحرة هي تلك الفتاة التي ظل يطاردها، كضوء هارب، منذ سنوات؟ فيما كانت نفسي تتهيأ لإخماد خوفي والرسو بي على ضفة الطمأنينة، وقف هشام فجأة أمام الطاولة يحمل صينية الشاي. أقبلت على قضم الخبز المدهون بالزبدة ومربى المشمش متبعا كل قضمة برشفة شاي، فيما اكتفى هشام باحتساء قهوة سوداء مدخنا سيجارة. كان الفضول القلق قد تجمع في صدري موشكا على الانفجار في وجه صاحبي، إلا أني تشاغلت بالإفطار مصبرا نفسي، ولم يفتني أن ألاحظ مسحة الهم التي رانت على ملامح وجهه،وهو ينفث الدخان بعصبية، وعيناه شاردتان بعيدا. لم أكمل التهام الخبز كله، وضعته على الصينية، أشعلت بدوري سيجارة، وقلت بصوت خفيض:
– ثريا شنقت نفسها، أليس كذلك؟
التفت نحوي متحيرا، دون أن ينبس بكلمة، فأردفت:
– أرحني أصاحبي، لا أحد يستطيع الهروب من قدره.
زفر الدخان إلى أعلى، في نفس يشبه تنهيدة طويلة، وخرج صوته متلعثما:
– هي فعلا أعبد العالي، لكنها ما زالت على قيد الحياة.
قفزت من الكرسي واقفا، وسألته بلهفة:
– أتقول إنها ما زالت على قيد الحياة؟
– هذا ما سمعت بعض الطلبة يرددونه، الآن، في المشربة. لقد حملتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى السويسي، وهي الآن في قسم المستعجلات.
درت حول الطاولة، وأمسكت بذراعه قائلا:
– وماذا ننتظر لزيارتها؟ فلنطر إليها بأقصى ما نستطيع بسرعة!